قراءة في ديوان “ليل يديها” للشاعر زاهي وهبي:
لعازر القرن الواحد والعشرين و أعجوبة الخلاص!
( خاص لموقع ” ميزان الزمان ” الأدبي في بيروت )
كتبت د. ساندي عبد النور :
من يقرأ بتمعّنٍ ديوانَ “ليل يديها” لزاهي وهبي يتلمّس جلّياً محورية الله في حياته و تحديداً في قصائده فالصفحة الأخيرة في الديوان الممتدّ على مئتي صفحة تُصَدِق على ذلك: “لم يكن الحظ يوماً معي. كان الله.” (ص. ١٩٨)
من هنا يفهم القارئ المتعمّق أنّ زاهي وهبي حين عنْوَن ديوانه هذا “ليل يديها” راح بقصده إلى أبعد من فكرة يديّ المرأة التي قد تكون حيناً الأم و أخرى الحبيبة أو حتى الأخت و الابنة.
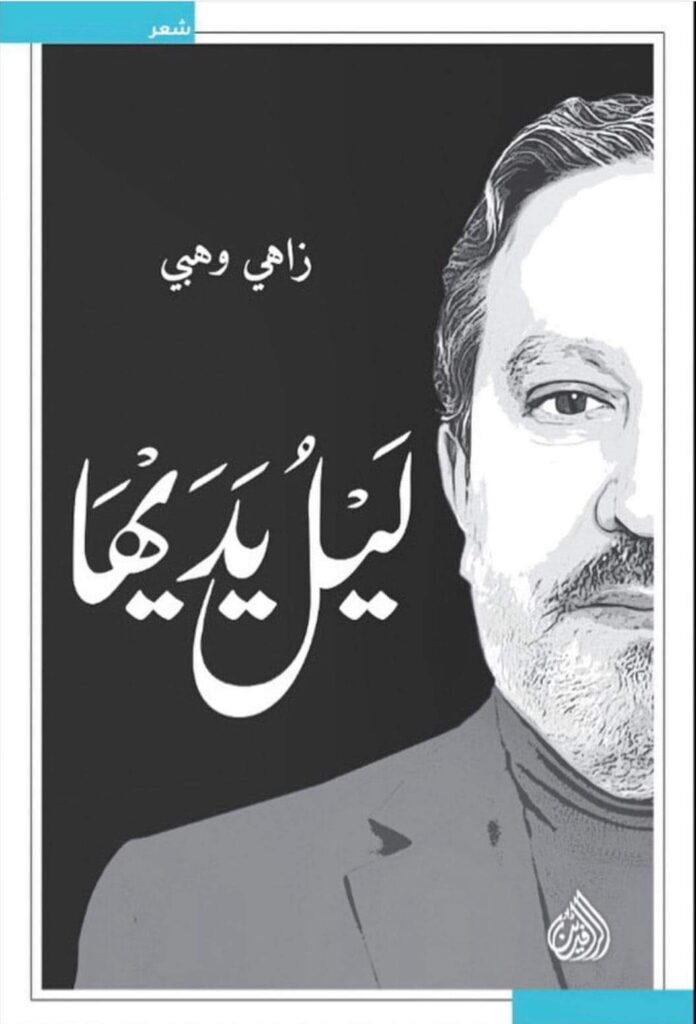
من تمحّص فعلاً في قصائد “ليل يديها” أدرك أنّ ضمير الغائب في كلمة اليد إنّما عائد إلى السماء التي رعته و ظلّلته و أنقذته من مخاضه حين نال منه وباء العصر و فتك به:
“عائداً من موتي
أضخّ الحياة في عروق الحياة
أرشّ الأرض قمحاً و أمنيات
أشرع الصدّر محراب صلاة
أقول للموت
تأخّرْ
في القلب متّسع للحبّ
في الرئتين هوى لا هواء”
(من قصيدة العودة ص. ١٥).
تلخّصت رحلته مع المرض و التي توّجت بالنجاة بفعل قوة الحبّ الذي تضخه السماء في سبع محطات توزّعت عليها المئة و الثلاثون قصيدة التي يضمها الديوان. جمعت المحطة الأولى” طوبى لي” أربع عشرة قصيدة، الثانية” وجهك رايتي” عشر قصائد، الثالثة” يدها الشافية” ست و ثلاثون قصيدة، الرابعة “ليل يديها” سبع و ثلاثون قصيدة، الخامسة “تطيب البلاد” ثلاث عشرة قصيدة، السادسة “نشيد البلاد” أربع عشرة قصيدة و السابعة و الأخيرة “إلهي” تسع قصائد.

و كأنّ الشاعر عبر هذه المحطات السبع يخبرنا بلغةٍ شاعرية متمكّنة نزيف روحه التي تصارع الموت بمفردها في عصر ٍ مريضٍ يتخبّط في الفراغ و الفوضى:
” وحيداً في زمن سقيم
سنواتي السابقة كسلى على الكرسي المجاور
ترمقني بعلامات استفهام:
لماذا لا أهرم مسقيم
لِمَ ينبعث في مساماتي رحيق فتوّة
و جوارحي دائمة التأهب؟”
(بلا سابق عناق ص. ١٩)
و يضيف في القصيدة عينها:”لا شأن لي بالمطارات المقفلة و الحدود/ لا شأن لي بفيروسات العولمة و الرياح السموم/ روحي سماء منقطعة النظير/ خيالي بساط علاء الدين” (ص. ٢٠) لتبلغ مهجته بالقصيدة برّ النجاة فتطيب البلاد كما عنون المحطة الخامسة و يصبح لها نشيداً “نشيد البلاد” عنوان المحطة السادسة فتصبح العودة التي بدأ بها في قصيدة الديوان الأولى هي عودة إلى الله في المحطة السابعة و الأخيرة :” إلهي” ما يجعلنا نتوقف عند الرقم سبعة و الذي قد يكون أتى بمحض الصدفة حين تمّ تبويب قصائد الديوان و توزيعها إلا أنّها صدفة بمدلولات عديدة فالرقم سبعة يشير إلى النصر فضلاً عن أنّ هذا الرقم جالب الحظ يرمز في العديد من الأساطير إلى الابن الذي يملك قوى سحرية. و بذلك نفهم أنّ الشاعر الذي كان الله معه كما سبق و أشار ما كان إلّا هذا الابن صاحب القوى السحرية التي جعلته يغلب الموت و يعود منتصراً، ظافراً إلى الحياة:
” أنا الصوفي
أدور حولي
أتلاشى فيّ
أغيب
لا من يراني، لا من أراه
وحدي أناجي وحدي،
و الوجوه غبار” (ص. ١٨)
فيجد نفسه يكتب لامرأة على غرار السماء أرسلها له الله:
“أكتب لامرأة من دموع الغيم
وجهها ماء السماء
قلبها حدائق بابل
صوتها فرات
و صمتها نشيد الأبد” (ص. ٤٥)

فنلحظ عبر هذه الأبيات أنّ لا فصل بين المرأة و السماء و كأنهما واحد و في تلازمٍ وثيق لأنّهما هدية عظمى ضد الوجع الذي ذاقه في صراعه المخيف مع الردى و ضد القنوط الذي خلّفه عالم العولمة الشرس و ضد السقوط الذي كاد أن يعانقه لولا تلك اليد الخفية التي أنقذته من انزلاقه و طببته من ندوبه و شفته فرجع مهلّلاً إلى الحياة :
” لم يبقَ لي من بلادي سوى يديك
و صلاةٍ أحفظها غيباً
لم يبقَ لي سوى الأغنيات التي سمعناها معاً
و المدى الشاسع في عينيك
و سماءٍ ما استطاعوا أن يسرقوها
و الدعاء الذي ردّدته صغيراً
و البكاء الذي عاندته طويلاً” (ص. ٤٥).
و هكذا فإنّ القارئ المتسلّق المعنى لا بدّ له أن يدرك أن لا يد أرحم على كائنٍ حيٍّ من يد السماء كما لا بدّ أن يتوصل إلى فهم الدور الذي لعبته هذه اليد المقدّسة حتّى يبرأ الشاعر و يُشفى من أسقامه الجسدية حين صارع المرض كما أسقامه النفسية فوهبي جزء لا يتجزأ من هذا العالم المجنون الذي أضحى بارداً و فاتراً و متشرذماً:
” كلما ضاق وطني عليّ/ ارتميتُ على صدرك/ عساها عن صدري/ تزاح الجبال” (ص. ٤٩)
فكلنا نبحث عن تلك اليد البارئة التي بمقدورها أن تزيل عنا المآسي و التي “(…) تكتب حظاً جديداً/ [كي] تتفتّح في يدي[نا] كوردة اللهب” (ص. ٥٤)
ل”يعود العالم طفلاً يطلق طيارته الورقية الملونة/ ضاحكاً ملء قلبه و خدّيه” (ص. ٨١) فيطلّ فيه حينها ليل يدها كبلسم.
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الليل المندرج في النظام الليلي بحسب كتاب جيلبير دوران “الهياكل الانتروبولوجية للخيال” يرتبط بكل ما يتعلّق بتقنيات الاحتواء و السكن و المأوى و الأمومة أي تحديداً ما يبحث عنه الشاعر كي تعود إلى قلبه العافية:
“أيها الكوكب الذي أفسده بنوه/ لا خلاص لكَ بغير الحبّ” (ص. ١٠٠)

من هنا سيعاين الشاعر بالحبّ و بشخص الحبيبة المرسَلة من السماء القيامة الحقيقية:
“فيك شيء من صلاة أمي/ و رائحة التبغ في غياب أبي/ شيء من ضحكات الصبيان تحت المطر/ و الأغاني العاطفية في مذياعٍ عتيق/ فيك شيء من بلادي” (ص. ١٠٩)
فتطيب حينئذٍ البلاد:” تقولين أحبّكَ/ يبتسم المارة و عابرة السبيل/ تكثر في القلب الأغنيات! تقولينها، تطمئن الصباحات الخائفة/ تطيب البلاد” (ص. ١٣٧)
و تنغرس في أوجاعه ابتسامة:” يا لهذه الابتسامة/ مباركة مثل قوت المساكين” (ص. ١٤٩)
و يغدو للبلاد نشيداً، نشيد الحب و الأمل و أكثر من ذلك نشيد الظفر من خلال الحب و الأمل:” مهما اشتدت الريح و عمّ الظلام/ ثمة شمس تضحك كل صباح/ و أم تصلي كي يعمّ السلام…” (ص. ١٥٥)
و نشيد المطر الهاطل في بيروت عاصمة الوطن:”تحت مطر بيروت/ لا آبه لفرح و لا لكآبة/ أسير كمن يطير/ لا مكان يعنيني، لا ما سوف يكون/ يكفيني أنني هنا تحت مطر بيروت” (ص.١٧١)
فيأتي مطر بيروت بمثابة معمودية لروح الشاعر الثكلى و المفجوعة و المتألّمة لكنّها الراجية أيضاً رغم أنف الظروف و المحن فبالحب وحده تُصنع المعجزات:
” بعد ألف عام، ألف حرب..
سوف يعثرون في الريح على صوتي
الذي لم ينصت إليه أحد يوم صرخت:
وحده الحبّ ينقذ العالم” (ص. ١٨٦)

لعلّ الله:”حبّاً بالأمهات/ [يجعل] فولاذ المدافع خردة/ و هدير الطائرات رحيق زهر/ [و يضع] في القلوب الصدئة مواعيد حبّ” (ص. ١٩١).
فنجد أمامنا لعازر المعاصر الذي بفعل الحبّ عاد حيّاً بعد أن أقامه الله الذي كان دوماً معه فأراد من خلال تجربته مع المرض و الموت أن نضع الله نصب أعيننا فنسير إليه وحده:
” كانوا يتسابقون نحو الجنّة/ و كنت مسرعاً نحو الله” (ص. ١٩٦).
كلّ ما علينا فعله أن نفتح قلبنا لنراه: “الضوء الباهر لا يرى بالبصر بل بالبصيرة” (ص. ١٩٧).
* ( د. ساندي عبد النور لبنانية من مدينة طرابلس و حائزة على شهادة الدكتوراه في اللغة الفرنسية و آدابها من المعهد العالي للدكتوراه الجامعة اللبنانية.)










❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️