د. قاسم قاسم كتابا:
أركولوجيا الرسوم المتحركة!
“يبدأ عمله ظهرا حتى منتصف الليل، والزبائن من جنسيات متعددة، يفضلون الأكل اللبناني التقليدي. أحيانا يمتلئ المطعم، وأحيانا أخرى تبدو الطاولات حزينة، تنتظر من يداعبها، وهي الحريصة على حفظ أسرارهم العاطفية، الدينية، والسياسية.”
ليس بالضرورة، أن يكون الفن الساخر، محصورا بريشة الرسام، ومعلقا كأيقونة هزلية على الصفحة الأخيرة من الجريدة. أو تزيينا قهريا، متشفيا وناقما على أوضاع العيش والحياة. بل ربما أتى في صيغة بيت شعر كرسوم متحركة. أو في قصيدة كاملة. أو في مسرحية كوميدية هازلة، أو في صورة رواية متتابعة، لوقائع وأحداث معاشة، يختزنها الكاتب في صدره لزمن طويل. يمتلئ بها، حتى لكأنها تنفجر به في سويعات الوحدة والخلو بالذات مع طبيعة الصمت المدوي في الذات.
” د. قاسم قاسم. رجل يفتش عن حاضره. بيسان، بيروت-الحمرا- شارع غاندي- 2025: 160 ص. تقريبا”
“أحس فعلا بالغربة، لأنه لم يزر منطقة الأسواق منذ أن جاء إلى بيروت، وهو السؤال الذي طرحته عليه سارة، فتجنب الرد معللا أن عمله يشغله ليلا. حالما إنطفات الأضواء، إبتسمت له ولصقت كتفها بكتفه. زم على نفسه وأحس أنه محاصر بها وبالعتمة، ولا مفر له سوى الإستسلام، فتكوم على كرسيه يبصر زوغان عينيه التي تاهت في مكان آخر … سألته أثناء توصيله: عجبك الفيلم؟
أجابها ببرودة: أي منيح.”
أجمل ما في هذة الرواية، هي تلك الإنسيابية مع الأحداث المتنقلة، في زمن العبث بالأمكنة والتاريخ والجغرافيا والسياسة. تصوير مثل هذا اللهو السياسي والعاطفي والجنسي، القاتل والعابر، ليس بالأمر السهل. لأنه يحتاج إلى إعتمال طويل في النفس، حتى يأتي محاكيا للواقع القاهر لها، مع كل حركة على الأرض.
” حين إحتضنت وجهه بكفيها، أخفى سروره لهذة الخطوة، وما أن لامست شعره، حتى جاءها هاتف، جعلها تقف على قدميها، معتذرة من عصام، ثم خرجت إلى الشرفة، وأغلقت الباب وراءها. شغل باله حديثها الطويل، فلما عادت، سألها بشيء من البراءة: خير إنشالله؟”….
إنجبت ثلاثة أيتم. بس حلف يمين ما بقا يروح، عسوريا مرة ثانية. ولي صديق إختفى على الحدود. ولم يعرف أهله عنه شيئا. وكل يوم بسمع بخبرية شي ما بيتصدق. نظام ما بيرحم حدا. المعارض مصيره القبر.”
رجل يفتش عن حاضره، في الركاميات، هو أعظم ما يذوقه المرء من عذاب النفس، وهو يراجع أحواله، على ساعة الوقت. فيرى كيف تنطوي البقاع كلها: مدينة منكوبة، وقرية شاكية، ورحلة سائمة، وأحاديث تختزل صور المهانة والذل اليومي، وصور الموت الإنفعالي، قبل الموت.
” بعد أسبوع أحاط به الجهاز الأمني، وأبلغه بوجوب الصمت والإلتزام بشرعية الله، وإلا نصيبك الإعتقال. إلتزم المجاهد عادل بالأوامر، وصار يعيش في أجواء الخوف وخصوصا أن المخبرين من الدولة الإسلامية إنتشروا حول مكان إقامته، وكانت الأخبار تصله من أحد اللبنانيين، من أبناء البلدات الشمالية المحرومة، أن الخصومات العقائدية، بدأت تنخر في جسم الدولة، وأن التكفير يتبعه التكفير. وكل فرقة تكفر الأخرى.”
د. قاسم قاسم روائيا، أوفى تجربته حقها، حين حكاها بصيغتها المتدحرجة على صدره، مثل صخرة سيزيف. رواها مجردة من كل زيف. ثوى على جمل همه، وطنا مقتولا بالأحداث الجسيمة، صيغة بعد صيغة. وعيشا بعد عيش. ودولة بعد دولة، يخرج من ظهرها ومن بين يديها، الدود والعنكبوت، والميليشيات والمشيئات العابرة للقارات، لأجل العبث بالخرائط، وإعادة كوكبة الأوطان، مجموعات مجموعات من حطام ومن عظام.
“أنذر الشيخ جاهل راشد، بعدم زيارة غرفته القديمة. ومع ذلك جاء، ومكث فيها قرابة الساعة، جالسا إلى سريره، يتأمل التفاحة التي تحولت إلى ما يشبه الرماد ولم يدر أن خطوة كهذه، يمكن أن تكشف سره. لكن إنشداد الإنسان إلى الماضي، يجعله في لحظة ضعف، فيترك حاله دون إرادة ، وينساق إلى تصرف فيه من الخطأ والصواب في آن واحد.”
لا ينسدل الليل عند الكاتب، إلا على هم فوق هم. إلا على أخبار فوق أخبار، إلا على دم فوق دم. كأن تصير الدنيا كلها في عينيه شاشة مفزعة للهبوب الدخاني والرملي الساخن، وللرحيل وللقتل والتقتيل، والدعوة للتعالي على الموت الطبيعي، بالموت المجاني، لرسم الخرائط بالدم.
” وكان عصام يتساءل في خلوته ووحدته: هل مكتوب عليه أن يضحي وأن يبقى دون علاقة مع زوجته منذ أن إستملكها مرض النوبات؟ وعندما لا يجد جوابا، يلجأ إلى القرآن، ويروح يتلو صورة النساء، بصوت خافت….* وإنكحوا ما طاب لكم من النساء، مثتى وثلاث ورباع…*
وضع بصره جانبا ومال إلى الشرود… ويتذكر تلك المرأة التي إنهالت عليها الحجارة من كل حدب وصوب وصراخها الذي صم آذان السماء في إحدى قرى تدمر، والتي تبعتها صرخات الطيور الكاسرة، التي كانت تراقب حقد بني البشر.”
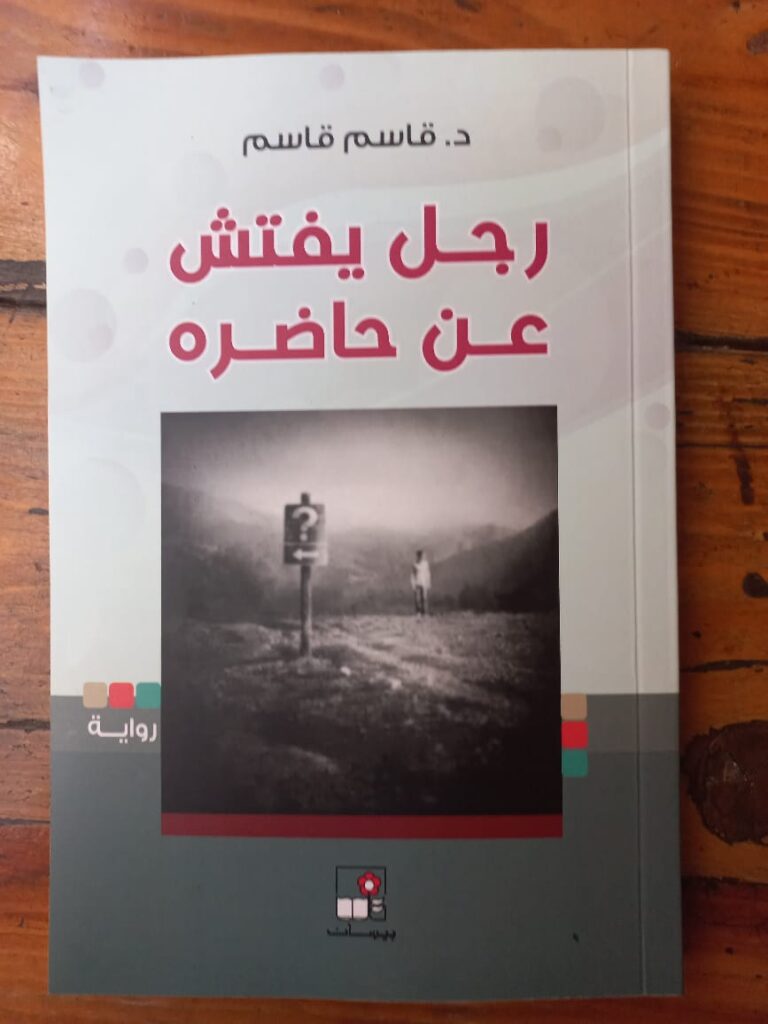
هكذا هو حاضر د. قاسم قاسم، يرى إلى نفسه،متدثرا بعباءة دهرية موبوءة بالشعوذات وبالحكايا المخابراتية، بصيغة السياسة الواعدة لليوم التالي. فيستيقظ من قلة النوم، على الفواجع الدانية. وعلى الأوطان الذبيحة. وعلى رعب الحكايات، في الطرقات لمسافات طويلة، لا يصل معها، إلا إلى حجرات الرعب، والنوم على جرائم تالية.
“ناما حتى الظهيرة. وعطش عصام للكتابة، جعله يدون عشر صفحات مع ركوة قهوة، وثلاث سجائر. بعد الظهر، جاءه إتصال من أخته، تدعوه فيها إلى عرس إبنها…جلس لمدة ربع ساعة، ثم هنأ أخته والعروسين وإنسحب معتذرا…
- إنتبهت أنك ما عم تقرب عاحدا.
- يا ميساء، أبتعد عصام عن الكل، وهلق عما يفتش عن الحياة.
- بعتذر ما إنتبهت لهالشي.” قطعة من العذاب، هذا هو حاضر الروائي د. قاسم قاسم، وهو يقص علينا بأسلوبه الماسخ للأحداث، مسوخ حكايا الناس العاديين، بألسنتهم المحلية. وبقلوبهم المشوهة. وبعقولهم، التي تلعب بها الريح، مع حبال الغسيل السياسي والعاطفي، المتسخة.
“داخ عصام، فإنسل إلى الخارج حتى وجد نفسه في مقهى، يفرغ ما سمع في صور الناس، وكل واحد صورته في داخله، يراها كل يوم في المرآة. يداعبها شكلا. وعند أي حادثة يبصرها بشكل واع، ومتسائلا بصورة خاصة عن سبب إخفاء زوجته، سر إختطاف أخيها.”
معجب هذا الرجل في صموده النفسي، فوق الركام، كصقر، يحدق حوله في الحطام. يبحث في عينيه، عن أشلاء الجريمة، التي زعزعت الطبيعة، وجعلتها، غير متسقة، لعيش الصقور و النسور، فوق الروابي، وفوق القمم. ترى الكاتب يهوي من عليائه كطائر عظيم جريح، ليجد نفسه محطما، مثل بقية الأشلاء، ركاما فوق ركام.
“أسدل ستارة القراءة، ليغالب أعصابه بالدخان، وبدا كالرخام لا تعبر في وجهه سوى قطرات دمع إنسكبت على خديه، تزحلقت حتى لامست ذقنه، وتابعت لتساقط على رسالة الوداع، وتحيلها إلى بانوراما من الأشكال اللونية الحزينة.”
د. قاسم قاسم، يرسم بالرواية هزال الواقع، وهزال عيشه، كما أمثال الناس العاديين، الذين يجري بهم النهر من مكان إلى مكان. لا يميزون بين الأمكنة ولا بين الأزمنة. ولا بين القديم والجديد. يجرفهم التيار، فيراهم غرقى الدعاوى الباطلة، وغرقى الرايات المتسخة. وغرقى الأحاجي والحجج والأحجيات.
“لم ينقطع التواصل بين أم عماد وعصام، تشكو له همها، لأنها بدأت تكره حياتها. وحين يسألها عن وعد إبنها،يأتي الجواب: إنشالله خير.”
يرصد د. قاسم قاسم، كهوف التاريخ، وجميع المسوخ الخارجة منه كأبطال مرعبة. يرى ظلالهم في الدساكر والعواصم والقرى، فيتعوذ منهم، بكل ما بين يديه، من أوراق ثبوتية، تؤكد أنه لا يزال يعيش، وليس جثة بين الجثث، في شاحنات المخابرات العاتية.
“عاتبها عصام على صمتها، فردت أنها لا تصدق كلمة واحدة منها. لكنها ذكرت أنها رافقتك أثناء فراركم من السجن. أيضا أجابت ربما هي. وربما واحدة تشبهها، لأن في تلك الاوقات العصيبة، يعمى قلب الإنسان.”
ما أصعب الحياة كجثة، يقول د. قاسم قاسم، في تلابيب روايته. كيف يجرؤ مثله كنسر، عار من الريش، فوق الحطام. كيف يتذوق الحياة بلا ريش، يخفق به في الأعالي.
إنه الموت الحقيقي قبل الموت الطبيعي، عندما يرى النسور في بلاده، مقهورة فوق الحطام، بلا ريش.
“مج سيجارته، وأجاب: والسياسة مغطاية بالدين. مثل الخليفة أو الحاكم اللي بيتمسك بالكرسي. ما بخلي شي وما بيعملو بأعداؤو. والتاريخ بيشهد عهالشي. وصفحاتو مكتوبة بالدم. وهيدا الشي عم ينطبق هلأ عند الدولة، وعند دولة النظام.”
نسيج العائلات المحطمة، يمسح عينيه كل يوم. تسيل بهم الطرقات. تغلق عليهم الأبواب. يخرجون بالعربات. يغوصون في القيعان. تعرى أنفسهم، من وهج الشوق، إلى خيط رفيع من الشمس. يصرخ قائلا: ما أقتل السجن!
“شعل عصام سيجارته الثالثة، وراح يتأمل شعرها الذي تداعبه نسمات الهواء. في حين لملمت الصحافية أوراقها وإعتذرت لإطالة الحديث، وشكرته على سعة صدره.”
حاضر مأساوي قاتل وسوداوي، هو حاضر هذا الرجل، الضائع في الأوطان بين الركام. يقص علينا، هزال الحياة، في أبوابها العادية، بلغاتها العادية البريئة من الدجل السياسي، والأكاذيب الدعوية المريضة بالأساطير. يقطع وقته، وهو يحل ألغاز الرياح المخابراتية، التي تلفح وجه القرى والبلدات والعواصم في الإقليم. ضاع عمره، وهو يعد الحصوات التي كان يرجم بها الزناة. أبقى الحصاة الأخيرة في يده، لتكون الضربة الأخيرة على نفسه، منتحرا من شدة الشوق، إلى غد يريده حقا، فلا يوافيه، وكأنه يحفر في رسوم متحركة!
” وقع الأمر في يد فاديا وهي التي غنمت السيرة، وإحتارت. أقنعها طارق بالإنصراف إلى الإهتمام بحالها. وهكذا بدا أن حبلها هو الذي خلط الأوراق فكثرت طلباتها وخاف في لحظة، أن تطلب منه لبن العصفور.. إلا أن الرجل الذي أضاع إسمه في مراحل الحياة السياسية، التي مرت بها سوريا، توفي بعد سنة بسبب إنتشار السرطان في دماغه.”
د. قصي الحسين
أستاذ في الجامعة اللبنانية.
 د.قصيّ الحسين
د.قصيّ الحسين

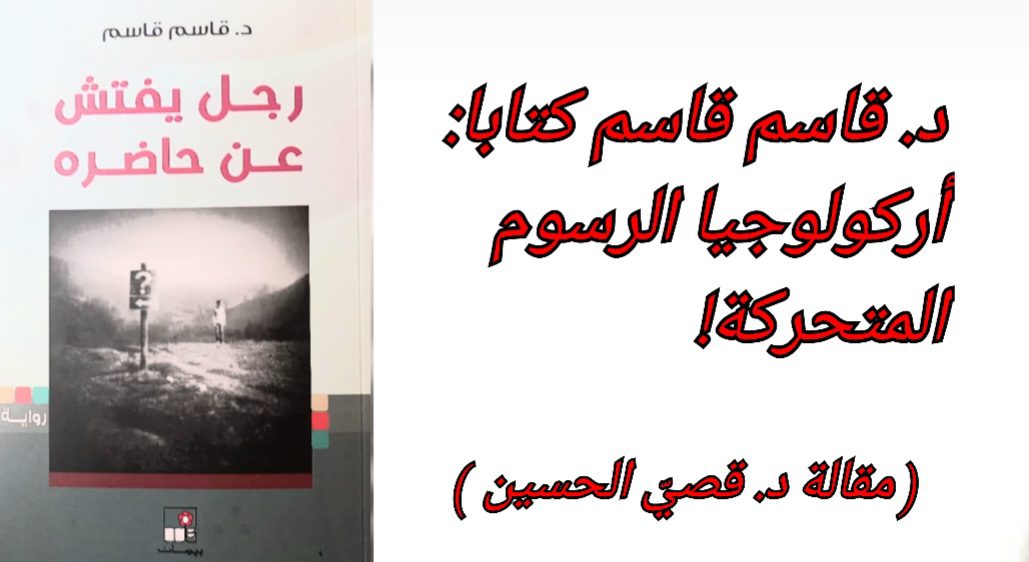







ممتاز..