كشفُ الكَوامِنِ في ” همْسِ الأماكِنِ ”
(دراسةٌ في ديوان ِالشَّاعرِ وليد عبد الصَّمد)
الجزء الأول
الدكتورة : هزار أبرم – سورية
في مهدِ القصيدة كانت المشاعرُ تتوسّدُ عذريتَها وبراءتَها بين كبرياءِ رجولةٍ شرقيةٍ, وبين حنينٍ خجول للطفولة, إلى تسليم ٍ بالحب, وتيهٍ, وهُيام, وتعلّق, وعشقٍ وتماهٍ فيه بلغَ حدوده, إلى مجونٍ أرستقراطيٍ كاد أن يبني إمبراطورتيه, إلى ناسكٍ فاقدٍ لذاكرته, والخمرة ُمسافرةٌ أبداً عبر كل المحطات بلا جوازِ سفرٍ, والمرأةُ بلا اسم سيدةُ كل الأماكن, لها تُقرعُ الأجراس ليبدأ الزمن ببدء حضورها, فكانت الدنيا والحياة والوجود, وأما غيابها فكان انهياراً وعدماً ودماراً وضياعاً.
وقد تجلّت هذه الأيقونات عبر(70) قصيدة شكلت الجزء الأكبر من ديوان “همس الأماكن” وما كان همسُ الأماكن إلا صدى صوتِ أيامٍ, ومحطاتٍ زمنيةٍ مرَّ بها الشاعر في تجربته الشعرية التي راحت تبوح بأسرارها منذ نعومة أظفارها فتُعبِّر عن خلجاته ومكنوناته الداخلية, وعلاقتها بشخصيته, وليس هذا فحسب, بل لتُعبِّر عن علاقته بالمرأة ذلك المحور الذي تركّزت عليه جملة من قصائد ” الغزليات” التي احتلت القسم الأول من ديوان الشاعر الذي احتوى على (121) قصيدة.
فمن يقرأ قصائد الغزليات, يُدرك بلا شكٍ أن المرأة اتَّخذت مكانةً وصورة ًخاصةً لدى الشاعر, وسرعان ما سنرى أن هذه المكانة ستتبدل في القسم الثاني من الديوان وهو ” الوجدانيّات ” لتتجسّد المرأة بكل تفاصيلها في كيان آخر أرحب وهو كيان الوطن والمدينة.
ففي قصائد” الغزليات” نجد أن المرأة قد ملأت دنيا الشاعر وليد وشغلته, لا بل كانت هي الدنيا, وقد ارتبط وجوده فيها بوجودها إلى جانبه أو في حياته.

بدأ الشاعر قصته مع المرأة حين استمع إلى صوت عقله الباطن وهو يتحدث عن كبريائه كرجلٍ شرقيٍ في قصيدة ” كبرياء”(27), ذلك الكبرياء الذي جعله يتحمل كبحَ صبرِه وصمتِه واحتراقِه شوقاً وشغفاً للاقتراب من المرأة, والبوح لها بما يعتريه من مشاعر تجاهها, إذ قال:
كبرياؤهُ الشرقي
يكبحُ صمتَه,
رغم احتراقِ
روحه ووجدانه,
شغفاً وشوقاً,
بانتظارِ لحظةٍ حالمةٍ
تدفعُ أبا الهول
للبوح…
ثم يأخذ الشاعر القرار ويفكر بالمرأة, وهو مازال يجهلها, ويجهل كُنْهَهَا, فلا يفتأُ عن التردد في سؤالها وهو في حيرةٍ : مَنْ تكونين؟ وذلك في قصيدة ” من أنت” (14), إذ يقول :
لستُ أدريك,
أتيت كفجرِ عيدٍ,
خلسة ًدخلتِ أيامي…
رقصنا, ضحكنا,
بكينا, تعانقنا, ولست أدريكِ,..
وبعد ذلك يُسلّم الشاعر بالحب وهيمنته عليه, ويفتَحَ له قلبَه, ويطلبُ من المرأة أن تعرفَه أكثر وتعرِفَ خصَاله ومزاياه فقال لها في قصيدة ” جربيني” (64) :
جرِّبِينِي…
فأنا ما زلتُ أرضاً عذراءَ,
صفحةً بيضاءَ,
احفُري جغرافيتَكِ على متَاهَتي,
حُلِّي وثاقَ مشاعري من وحدَتِها…
علميني كيف تكونُ التجاربَ مع النساء.

فالمرأة قد ملكتْ كيان الشاعر وأصبح كتاباً مفتوحاً من الحب والهوى والمشاعر النابضة, فعبر الشاعر بكل لفظة من ألفاظه أو كلّ نبرةٍ من نبرات حسّه عن حبه, مستسلماً لذاته, ولقلبه, ولنفسه, ونراه يقول أيضاً في قصيدة ” غزلُ كلماتي”(60) :
يا كلَّ امرأة دنت من شطآني
يا كلَّ امرأة رستْ على أوتاري, يا كلَّني,
اجتمعت لدى الشاعر كل النساء بامرأة واحدة, وصارت كُلَّهُ وكيانه, وقد تملَّكته وكأنها استبدّت به حتى تماهى بها, حتى راح يهذي بها, فقد أصبحت النبضَ في عروقهِ, فقال في قصيدة ” أغرّد هذياني“(42):
يا امرأةً اختصرت دنيايَ
ماذا فعلت بي؟
قُربك نارٌ وبُعدك جحيم,
أهيم ُ في ثنايا ابتسامتك,
حتى أصبحتِ النبضَ في عُروقي.
وليس بعد هذا الهيام بالمرأة إلا التغنّي بأوصافها بأكثر من قصيدة, إما بالوصف المباشر الصريح, وإمّا بالوصف غير المباشر, وتجلى وصفه المباشر في قصيدة “طيف” (58)، وفي قصيدة “هيفاء”(68) حيث قال:
هيفاءٌ تَغار منها الأزهار
ومن همسها تُطربُ الأنهار
تمر في البال سحراً
يفيض بها الصباح…
أما الوصف غير المباشر, فقد تجلّى حين بلغ الهيامُ والعشق عند الشاعر منتهاه وأصبح تائهاً غارقاً في الحب لتلك المرأة حتى الثمالة, وقد سلَّمها روحَه ومصيرَه ومستقبله, فراح يقول في قصيدة “منذ الأزل”(38):
جمالها الأخاذ بعثرني…
كَبّلَني برقتها وسحرني…
سلّمتها روحي…
مصيري, مستقبلي, وحنيني
آهٍ و آهٍ …. لماذا تأخرتِ؟
ميعادنا مرسومٌ منذ الأزل…
وكان جديراً بهذا الحبّ والهيام والعشق الذي أحسَّه الشاعر اتجاه المرأة أن يُحقِّقَ له سعادةً لا مثيلَ لها, وحياةً سرمديةً, ولكن على العكسِ فإنه قد خلّف في نفسه عقدةَ كعقدة أوديب, عقدة َالخوفِ من ابتعادها عنه, وقد عبَّر في أكثرَ من قصيدةٍ عما يحدث لو ابتعدتِ المرأة عنه وغابت عن حياته, فنجده يصف حاله وضعفه وانهياره, وقد أصبح وكأنه في حالةِ موتٍ روحيٍّ, وعبّر عن ذلك في قصيدة “ من دونها “(66):
في ابتعادي تنهار قِواي..
تخمد أنفاسي…. تضمحل رؤياي…
هي الكل في دنياي … من دونها….
لا طعم, لا لون, لا عِطر, لا صوت
مما تحتويه الأيام…
منزوع الروح … بلا عنوان
إلى أرضِ اللامكان.
وحين لم يستطع الشاعر تَحمُّلَ الوحدةِ والشوقِ والبعدِ, أعلن تَمرّده على الفراقِ واصفاً حالَهُ وصراعه مع الصمتِ, معلناً ثورتَه, وأنه سيُزيلُ كُلَ الحواجز بينهما, ويأخذها ويمضي معها إلى جنان العشق, وقد تجلى ذلك في قصيدة “جنان العشق”(51).
وعلى الرغم من أن تلك المرأة كانت تسكنُ قلب الشاعر, فإنه لم يستطع أن يمنع قلبه الذي لابُّد أن يستفيق على حقيقة بعدها عنهُ, من أن يئِن وهو يرزح تحت وطأة الجراح والحزن, ولا يكفُّ عن إسكات تساؤلات متلاحقة راح يطلقها دون انتظار إجابة, فقد راح يبحث عنها في كل الأماكن, وحتى في الأحلام لعلّه يجدها فتهدأ روحُه وتسكن جراحه, فيقول في قصيدة ” أنين قلب”(50) :
يا مَنْ احتجزْتِ معكِ الروحِ
خطفتِ المشاعر رحلتِ بعيداً
تركتني أنْتِشي بالجِراح,
بحثتُ عنكِ الأماكن..,
بحثتُ عنك في الأحلام,
لا جواب…
وفي تناقصٍ صارخ، ورغم حبه الكبير، فإن الشاعر يعترف في أكثر من قصيدة أو موضعٍ بتعدد تجاربه مع النساء, ففي قصيدة “ أغرّدُ هذياني” (42), ينقل لنا مشاعره المتناقضة, ففي الوقت الذي يشكو فيه الشاعر من غرقه وتيهِهِ في حبِ امرأة اختصرت دنيَاه كلَها, وأصبحت النبضَ في عروقه, راح يقول لها : انتشليني من غرقي,
فأنا ما زلت يافعاً في عالمك,
أبحرتُ ثلاثين عاماً بين النساء,
وفقدتُ سفني أمامَ عينَيكٍ,
فها هو الشاعر يدَّعي العفاف وأنه مازال يافعاً في عالم الحب, ولا يفتأ يعترف في الوقت ذاته كيف أمضى ثلاثين عاماً بين النساء, لكنها وحدها من بين كل النساء تستطيع انتشاله من غرقه, فقد ضاعت سفنه أمام سحر عينيها.
ولعلنا نقف في المقطع الشعري الآتي أمام صورة شخصية الشاعر الحقيقية, أو بصمته الخاصة, ونسمع صوته الداخلي الذي يُردده دائماً في سرّه, والذي لم يستطع كتمانه, حين يقول في قصيدته ” ثلاث نساء” (57):
كيف أكتب النهايات,
وفي فمي ثلاث نساء؟
حمراءٌ تتهادى,
سمراءٌ تتلوى,
شقراءٌ تتغاوى,…
أنا عاشقٌ تائِهٌ
في بحر الجميلات.
فهذه الأبيات هي المفتاح في فهم شخصية الشاعر وليد الذي أبداً نجده عاشقاً هائماً بين الحسناوات, تائهاً, حائراً, قلقاً, يتردد على فمه السؤال, أمضى عمراً يبحث عن ذاته في عالم النساء, فعاد بخفي حنين.
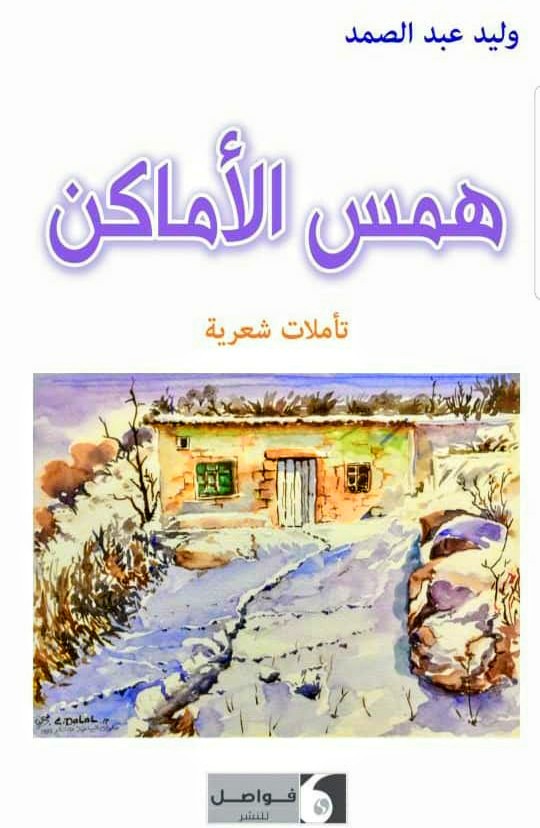
أما صورة الخمرة وتجلياتها عند الشاعر, فلا نستغرب لو أحصينا عدد القصائد التي ورد فيها ذِكرُ الخمرة إما ذِكراً عابراً, أو مقصوداً لذاته, أن يبلغ عددها حوالي (30) قصيدة في ديوانه ( في قسم الغزليات), وأن لفظة ” الخمرة ” هي من أهم مفردات معجم الشاعر وليد, بل كانت جواز سفرٍ عبر مسالك القصائد كلها, واحتلت مكاناً في عناوين محطاتٍ مهمة, وقصائد خاصة بها من مثل قصيدة : خمر ندي (82), خمر (102), أرتشفتها خمرة (67), وغيرها.
فقد استطاع الشاعر أن يدير دفة الخمرة إلى مكانة مميزة, فجعلها أنموذجاً خاصاً به, ولم يتطرق إلى وصف لونها وشكلها ومجلسها, ومستلزماتها, ولكن الشاعر وليد جعل من الخمرة ” حلية براقةً ” زيّن بها قصائده في قالب شعري مميز اختار ألفاظه وصوره وعباراته وتشابيهه ليؤثر في المتلقي ويوصله إلى مستوى الشعور الذي عاشه, فعبّر عنه, ونقله بكل صدق وإبداع.
كما عمَد الشاعر إلى الابتعاد عن التعبير المباشر أحياناً, وذلك باختياره لمفردات لا تقف عند معانيها المعجمية, بل تحمل دلالات وإيحاءات أخرى تمنح القصيدة شكلاً خاصاً, كأن تدل الخمرة على القبلة, كما في قصيدة ” رقصك “(72), والشوق, في” زرعتك قمحاً” (77), والضياع في ” تيه” (37) و الدواء الشافي في “تمزق ثوب ” (90), والعشق في قصيدة “غزل كلماتي” (60) وجميل الحديث والكلام, في قصيدة ” وهج “(99), والمرأة, في قصيدة “شهوتي” (73), أوقد يمزج الشاعر بين المعنى الحقيقي للخمرة والمجازي كما في قصيدة” بين البوسفور ومرمرة “(34).
أما القسم الثاني من الديوان وهو” الوجدانيات “ فيشكل خطاً بيانياً لدقات القلب, وصراعات الروح بين تيهٍ وصمتٍ ووحدةٍ, وحزنٍ وضياع, وبين حنينٍ للحب والعشقِ, ثم يأسٍ وغربةٍ وعزلةٍ, ثم يقظةٍ لابُدَّ منها رافقها شعورٌ من كبرياءٍ, وثقةٍ بالنفس أدتْ إلى ظهور نرجسيةٍ دعت إليها انتفاضة الروح, وتجددها, فراحت تفرِض ذاتها, وتعيش مخاضاً عصيباً من أجلِ ولادةٍ جديدةٍ, وتحوّل من بحثٍ عن الذّات التي تاهتْ زمناً في عالم المرأة, إلى بحثٍ جديد في عالم أرحب وهو ” الوطن “, بحثٍ اقتضى تحولاً في شخصية الشاعر التائهة إلى شخصية ثوريةٍ ناقدةٍ لكل السلبيات التي تُعَكِرُ أمن الوطن وسلامته وجمالهِ, وهكذا ينشغلُ الشاعر بهموم بلده, وأحوالهِ السياسية, التي عبَّر عنها في عدد من القصائد منها: المعتقل (177), اسكت (171), وبدا الشاعر كأنهُ سياسيٌ محترف, فتجلت صورته في قصيدة : زعماء (193).
ولعلَّ التحوّلُ المهم في شخصيةِ الشاعر, لم يأتِ عفوياً, أو بقرارٍ مسبقٍ, وإنما جاء بعد صراعاتٍ نفسيةٍ مع ذاتهِ, ومع وحدتِهِ, وحياته ومتاعبها. وتجلى ذلك أيضاً في عدد من القصائد منها, قصيدة “ابتعدوا ” (151), قصيدة “عابر سبيل ” (185), التي يصف فيها الشاعر حاله وهو يمضي سائراً وحيداً والقلق يرافقُهُ كظله, يُصارعُ آلامَهُ, وأحزانه وشكواه, حيث يقول:
أسيرُ وحيداً إلا من قلقِي
أعاهدهُ بثوبِ خشوعٍ,
أن لا أبْعدُهُ عني,
وأن أبقى حراً,
حروفي تساورني,
فيضُ ألمٍ وشكوى,
من سكرة ِالبوحِ…
حالة شعورية غريبة قاسية, كيف يألفُ المرءُ قلقه !!, ويعاهدُهُ ألا يهجره أو يبعد عنه…؟؟ ويعاهدهُ أن يبقى حراً, في حين يعيشُ حبيسَ آلامهِ وشكواهُ !! وأي معنى لحريةٍ تكون مرهونةً بالخوفِ والرهبةِ!!
وصورة أخرى لا تقلّ قساوة, تكمّل مشهد إقرار الألم في نفس الشاعر, وانتظاره لأملٍ من رحمِ ليلٍ بات فيه الشاعر مجروحاً, يشكو وحدة وهجراً, كما في قصيدة ” رقصة طير”(184). وتُكملُ قصيدة ” فوحُ الصمتْ “(134), صورة حال الوحدة والعزلة التي سيطرتْ على الشاعر واستسلم لها, فقال:
بمقهى بعيد,
جلستُ وحيداً,
أعاقرُ ليلاً,
أهمس بوحاً..
أنادمُ خمراً,
أسكرُ روحاً…
إمعاناً في الصمت والوحدة, يركنُ الشاعرُ إلى مقهى بعيد, يجالسُ وحدته, مستسلماً لصمته, بل للبوح همساً, والخمرُ نديمهُ, فتسكرُ روحه, و تتعتّقُ جراح عمره, وآلامه التي لم يُفصح عن جوهرها الحقيقي إلاّ قليلاً, بلمحاتٍ وصورٍ غامضةٍ أحياناً, وحين لم يكن يستطيع الشاعر كتمان انفعالاتهِ, فلا يُحرجُ من دموعه التي قرّحَت عينيهِ, والتي غالباً ما كانت نتيجة شدةِ معاناتهِ وآلامهِ, فقد ساهمتْ تلك المعاناة في تكوين فلسفته, ونظرتهِ للحياة, كما أثّرتْ إلى حدٍ كبيرٍ في معتقداتهِ, وفي إطلاق أحكامٍ خاصةٍ بهِ ولا سيما فيما يتعلّق بحياتهِ وصراعاتهِ, فأكثر ما تجلى من هذه الأحكام أن العمرَ بالنسبةِ لهُ كلُّه ألمٌ بالمطلق, وقد عبَّر عن ذلك في قصيدتهِ التي حملت عنواناً صريحاً ” العمرُ ألمٌ “(170), إذ قال:
العمرُ ألم ٌهدَّهُ الفرح
والجرحُ صوتٌ ينزفهُ التعبْ …
والروحُ شوقٌ يُغْنيِها العتبْ
تروي الآهات والدمعُ قُرح
تبني حياةً حروفاً تنسكب.
فنحن بلا شك أمام تجربة شعورية لذات تصدَّعت, وانكسرت, وظلت تنتظرُ وتبحث عمّن يُلَملمَ أجزاءها المتعبة, بعد مرارة, ومن ثم هروب وعزلة.
ويظلُ الشاعر هائماً في دوامةَ تيِهِهِ وغربتهِ بحثاً عن ذاتهِ, فأيامه باردة, وروحه غارقة باليأس, وهو ذاهل من تعطشهِ لأيامٍ كانت تضج بالحياة والفرح, فحاول أن يسرقَ بعضاً من ملامحها خِلسةً, في مشهد بكائه هذا الضياع والوحدة, فيقول في قصيدة ” بحث” (154) :
أبحثُ عني…
تهْتُ في غفلة مني,
صقيعُ أيامٍ….
جفافُ ليالٍ طوالٍ,..
أقرأ تاريخي…
صفحات دون كلام…
مجدٌ هاربٌ…
صفعة بلا ألم…
لم يتبقَّ لي شيء,
سوى الذهول من الأنا
المتعطشة لنيران الحياة,
أمرُّ عليها خلسةً,
أبكي الضياع,
ولكن من يقرأ قصيدة ” حالتي “(116), يُدركُ أنها تُمثلُ صورة لبدايةٍ جديدةٍ, أو إشراقة شمسٍ جديدة في حياة الشاعر التي كادت أن تصبح عقيمة, وبلغت أعلى درجات الاستغراق في اليأس والوحدة والعزلة, والضياع الذي لا عودة منه, ولا أمل في شيء بعده, فكان لا بُدَّ من بصيص أملٍ لتستمر عجلة الحياة.
لعلّ سبب جُلِّ معاناة الشاعر يعود إلى فراغٍ عاطفيٍ, ووحدةٍ لم يعتد عليها, وربّما كان يحنُّ لماضٍ كان عامراً بفيض مشاعرٍ من دفءٍ واستقرارٍ, وفرحٍ, وحبٍ, وأمان ! إذ أننا نسمعُ أحياناً في ثنايا أبياته الشعرية, صوت روحِه التي تتوق لماضٍ جميلٍ غادرهُ, وما زال قلبهُ يَضجُّ ويحنُّ للحب والعشق الآفل, كان هذا الصوت أشبهُ بصوت ضميره الذي راح يقضّ مضاجعه, ويُشعلُ حنينهُ لزمنِ الاستقرار الروحي. فيقول في قصيدة “ غريب “(115):
غريبٌ أيها العشقُ
تقتربُ مني ولا تلامسني
تُحيّرني, تُبعدني عما أبتغي,
أعيش الوحدة والقصيدة
مع حبيبٍ خذلني, فأصبتُ بالغياب…
ووسط هذا الصراع مع الذات والضياع واليأس, يلوح بخاطر الشاعر” صورة الوطن” الذي يضج حبُهُ بداخله, لينبعث الأمل في قلبه, وتشرق الحياة في روحه من جديد, فينهض محطماً صمته, منتصراً على يأسه, فيقول في القصيدة ذاتها:
الأملُ اشراقٌ عن الغروب
وطنٌ نرتشفُ خمرُهُ,
فعل ٌ يروي جماد َ الأيام
فيطلق الصمتُ بوحُ شدواً
وكان لابدَّ من صحوة تُعيدُ لهَ توازنه, فيخرج من صمته ويأسه, معلناً يقظته وولادة مرحلة جديدة في حياته, وقد تجاوز الكثير مما كان يضنيهِ, ويكبّله عن النهوض من حياته الضبابية اليائسة, فعبّر عن ذلك في قصيدة ” حُلتي الجديدة” (128), فقال :
فجأة استفقتُ على نفسي,
لأَجدني قد تخطيت الكثير,
لماذا أغامر؟ لماذا أتجاوز مبادئي؟
أهي انتفاضةُ روح ؟
أم هروبٌ من واقع مر؟
سأعيد حساباتي من جديد,
وأرتبُ أوراقي المتناثرة…
ذلك هو الحب العميق للحياة, ومحاولةٌ لاجتياز متاهة الضياع تلك, وتخطي الظلام الداخلي الممزوج باليأس, واقرارٌ بالعودة لترتيب الحياة من جديد.
ولعل السّر في هذا التحول كان ” الوطن”, فقد كان هو مبعثَ الأمل والحياة, ومصدر الانبعاث والولادة الجديدة للشاعر, لذلك لا عجب من أن يتربع الوطن على عرشِ قلبه وعقلهِ, ويُصبِحُ جُلَّ همه, بل عالمه, وذاته التي قضى عمراً يبحث عنها في عالم المرأة التي كانت في زمنٍ ” كُلَّهُ “, دُنياه, وجوده وبقاءهُ,… وقد لمسنا ذلك بشكل جليٍّ في” غزلياته”.
فأيةُ مكانة احتلتها المرأة في وجدانيات الشاعر وليد ؟ لم تعد المرأة بالنسبة للشاعر وليد ذلك المحور الذي يدور حولهُ سواءٌ للتغزل بها ووصفها, وخطابها وعتابها واستجدائها, أم وسيلة لرسم عالم حبّهِ ووجودهِ, بل اتخذت المرأة صورة جديدة, وأصبحت حاضرةً في ذاتٍ أخرى هي ” ذات الوطن”, فكل ما كانت تعنيهِ المرأة ويحتاجهُ أو ما يمكن أن تقدمه لهُ المرأة, أصبح الشاعر يجده في كيان وطنهِ.
وإن كانت المرأة أيضاً تشكل لدى معظم الشعراء أو الرجال عامةً ” الوطن”, فإن الشاعر وليد كان يرى في وطنه “مدينته بيروت” كل ما كان يحسُّه, أو يراهُ في المرأة, فقد أعلن في قصيدة “خمر”(107), أن المرأة أصبحت مدينتهُ, وكان يعني ما يقول حقيقة, فقد قال:
والمرأة مدينتي,
عاقرتها دون خمرٍ
بشفاه الموج…..
تتسلل إلى داخلي
فتنقلني إلى أفقٍ أعيش مداه
لم تعد المرأة تشغلهُ كشخصٍ وكيان, ولم يعد يحفل بها, وبأوصافها, ومناداتها, وخطابها إلا نادراً, حين يتوقُ إلى حضنٍ دافئ, ويشعر بعلاقته الفطرية معها, أي أن المرأة أصبحت لدى الشاعر حالة مؤقتة عاشها, خاطبها, بثها حزنه وفرحهُ, وصفها وأفصح من خلالها عن جملة من المشاعر, ولكنها بقيت حالة مؤقتة مرهونة بالحدث الذي جمعه بها, وقد عبرّ عن ذلك في قصائد عدة منها ( غريب (115), ظمأ (143), العشق (118),…), فمن يسبر أغوار شخصية الشاعر يُدرك أن هذه الحالة, قد تحولت إلى رمزٍ دائم تجسّدت فيه المرأة بكل تفاصيلها في كيان وطنه ومدينته التي أشار إليها بأكثر من نداء, أو عنوان عنون به بعض قصائده نحو: مدينتي (122), وليس بعدك (160), و” أحن إلى بيروت ” (128) التي يقول فيها:
ظلالها أعلى من جبالها
خيالها أوسع من فضاء
أحب فيها غربتي,
والأماكن,
أحب ليلها والمساكن,
أحب ما أكره فيها,
لأنها بيروت…
وأما في قصيدة ” ليس بعدك” (160), فهي تفصح عن حالها, وتخبرنا عن هذه الحبيبة التي ليس بعدها حبيبة, فهي فريدة, وقد عشقها الشاعر منذ صغره, وعشقها أنساهُ كل أهله وأحبته, وخلانه, وقد هَامَ بكل تفاصيها, فهو يقبلها كل صباح, ويحضنها كل مساء, لأنها كُلُّه, بل هي روحه وأنفاسهُ, حيث قال فيها:
وكانت صبية…
عشقتها منذ الصغر…
أثملتني بحبها… بكل ما فيها من صور,
تغلغلتُ في حناياها…
أنستني أهلي… أحبَّتي… خلّاني
أهيمُ بها… بكل تفصيلٍ…
هي كُلّي … أنفاسي وروحي,
ولم يكتفِ الشاعر بوصف عشقهِ لها, بل راح يتغزّل بمدينته كحبيبة أزلية, فجسّد بها كل أوصاف المرأة الحسناء الباهرة الجمال, وراح يسبغها على المدينة المعشوقة, كما يراها, فيتابع وصفها في القصيدة ذاتها:
على صدرها… أتعبّد القدر..
أناجي مقلتيها…
فهي حورية… تتغنى جمالاً وبهاءً,
حنطية بعيون سوداء
شعرها شلالات من البشر
فهذه الصورة الجديدة, كانت بمثابة الولادة الجديدة, حيث يهيمن الوطن على روحه وعقلهِ. لكنه لم يوصد الأبواب من حوله لينغمس في عشقه الجديد, بل ترك نفسه لتأملاته, وراح يرصد لنا محيطاً قريباً منه ومن نفسهِ كأن يصف لنا فنجان قهوته, أنيسه ونديمه, وصديقه الوفي, ورفيق ضجره, في قصيدة ” فنجان قهوتي” (125), كذلك يصفُ بعض عناصر الطبيعة في قصيدة ” نسمة الصباح” (139), ثم يصف مداده و أوراقه المبعثرة حوله, التي ضمّنها كل أشجانهِ وأسراره في قصيدة ” أوراق متناثرة” (148).
ثم ينتقل الشاعر لمرحلة أخرى بدا فيها أكثر صلحاً مع ذاته, ينعم بهدوء داخلي واستقرارٍ نفسي, وربما راح يشعر بخلاصٍ حقيقي من كل تلك الصراعات والمعاناة التي رافقته زمناً وعاش أسيراً لها من خلال قصيدة “حياة ” (156).
لقد كانت الدفقات الشعورية التي بثها الشاعر في تأملاته الشعرية, ماهي إلاّ نغمات تنتظمُ مع نبضاتِ قلب المتلقي الذي وقع تحت تأثير تجربة الشاعر, تلك التجربة الصادقة البعيدة عن التكلف بامتياز, لأنها تعكس شخصيته التائهة القلقة, والغامضة أحياناً.
وبعد, فهذه نظرات تحليلية للتأملات الشعرية في ديوان همس الأماكن اعتمدت المنهج النفسي الانطباعي, وستليها دراسة أسلوبية تصف أدوات الشاعر اللغوية في مستوياتها ( الصوتية, والتركيبية, والدلالية, والبلاغية).








