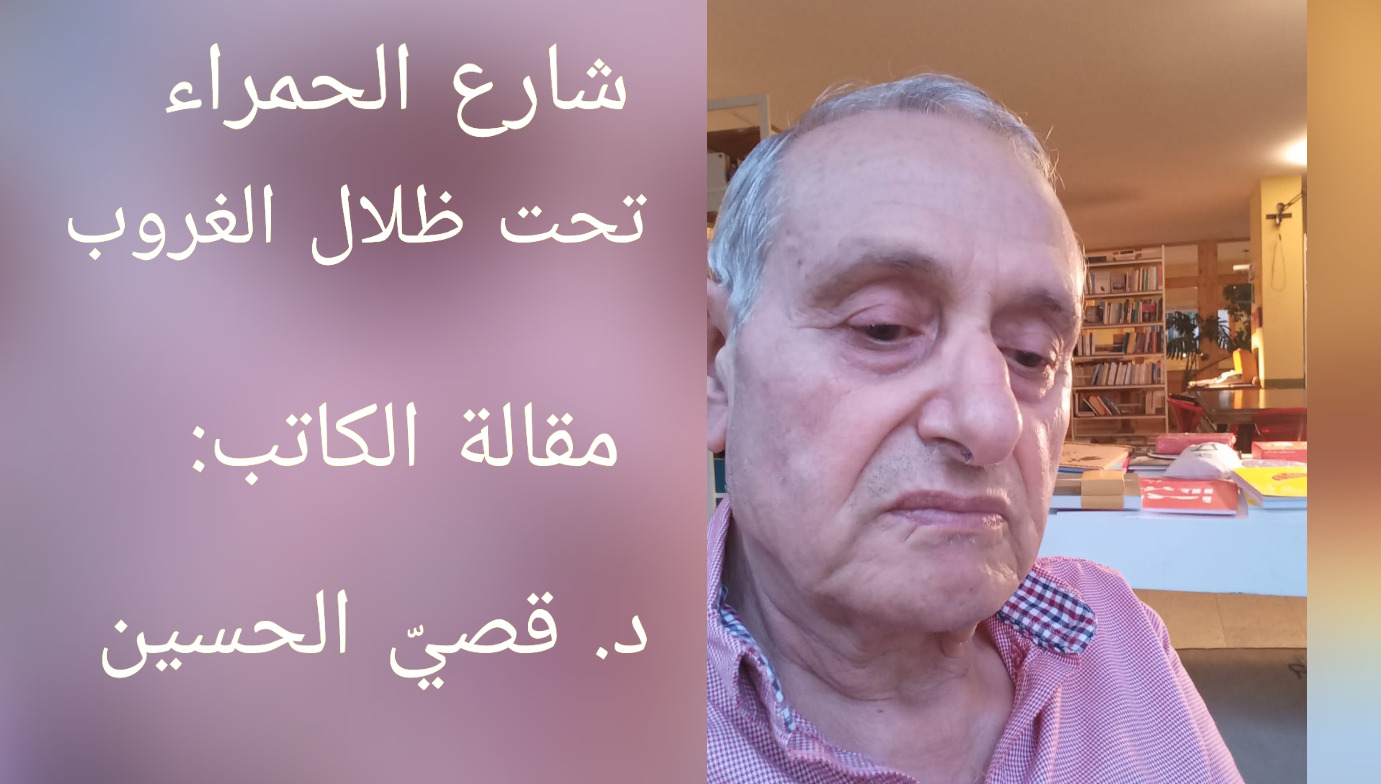شارع الحمرا
تحت ظلال الغروب
من لا يعرف سطوة الشمس، لا يعرف معناها، حين تنسحب ظلال الغروب، وتنصرف الشمس، لتنام في البحر أوفي البوادي، أو في الفيفاة، أو في مغارة خلف الجبال.
هكذا شعرت في أعماقي، معنى مدينة عنجر. طلعت عليها شمس الأمويين. ثم فجأة إستأذنتهم بالغروب بعد خمسين عاما. تغيرت الدول. صارت الخلافة في بغداد. لم تعد في دمشق. طوت الشمس “يطقها”. غادرت عنجر بلا إستئذان. فبقيت في مكانها شاخصة بكل أسواقها. بكل هياكلها. بكل أعمدتها. بكل ساحاتها. بكل بلاطها، بكل حجارتها. تنز دما ودمعا. تفجر ينابع منها، في برك رأس العين. وتملأ ساحاتها بالبكاء.
ظلال الغروب عن مدينة عنجر، تحاكي “ظلال الغروب” عن شارع الحمرا. فارق الصورة. فارق المشهد. فارق الوقت، أني قرأت عن ظهور الشمس على مدينة عنجر، في كتب التاريخ وفي كتب الجغرافيا. وفي الكتابات عن المدن والدول. بينما رأيت بأم عيني، طلوع الشمس وغروبها عن شارع الحمرا. قرأت ذلك بعيني.
كنت في الثانية عشرة، عندما إصطحبني والدي، من “أوتيل ديو” في منطقة المتحف، ببيروت، إلى شارع الحمرا. خرجت بصحبة والدي، من المستشفى بعد عملية جراحية في عيني، لزيارة قائدة الشرطة العسكرية، العميد سعيد بك الحسن، في مكتبه، في قيادة شرطة بيروت بفردان، بجانب تلة الدروز، وبيت الطائفة. إحتفى بنا كثيرا. تعاطف معي. لمست عاطفته، لأنه لمس رقبتي، حنوا منه، لأنني بعين واحدة. كان منظر وجهي يستدعي عواطف الناس الذين كانوا يرونني عن كثب. عن معرفة. كانت الزيارة لربع ساعة. إنحدرنا بعدها إلى شارع الحمرا، إنحدرت بصحبتي والدي بعين واحدة في الثانية عشرة من عمري، من نزلة البرستول، أو من نزلة السارولا، لا أذكر. ما أذكره، هي تلك الدهشة الطفولية، لرؤية الثكنة في فردان بعين صغيرة واحدة. لرؤية شارع فردان، وتلة الدروز، وبيت الطائفة. كان أبي دليلي السياحي ومرشدي. يشير بيده، لأنظر هذة العمارات العملاقة بعين واحدة. وهذة الشوارع النظيفة. وهؤلاء الناس، الذين يسيرون في الشوارع، بكامل زينتهم. كانت “الترمواي”، وسيلتنا للوصول من المتحف إلى فردان. وكانت السيارات في شارع الحمرا، تخطف الألباب، لجمالها ونظافتها. وكانت الشوارع التي تصب إلى شارع الحمرا، دقيقة النظام. دقيقة الإنتظام. نقطع الطريق بين المسامير، حين تضوئ لنا إشارة السير الخضراء. ونتوقف مع الناس، لمرور السيارات، حين تضوئ لنا الشارة الحمراء.
إصطحبني والدي في زيارته لنائب عكار، سليمان بك العلي. قال لي: إن سليمان بك، نزيل أحد الفنادق في شارع الحمرا. قال لي: إن جميع الفنادق التي أراها في شارع الحمرا، ينزل فيها، النواب والوزراء وكبار القوم، القادمون إلى بيروت، من المناطق. وينزل فيها أيضا، السفراء والقناصل والسواح الأجانب. رأيت ذلك بعين صغيرة، لطفل صغير في الثانية عشرة، فعلقت في قلبي وبهرتني، فما أنساها حتى اليوم. لا أنسى تلك الزيارة المبكرة، لشارع الحمرا، ماحييت.
لا أذكر اليوم الفندق الذي كان ينزل فيه، سليمان بك. لكنني أشتبه به. أذكر أني مررت من أمام سينما البيكادلي. وصلنا إلى تقاطع عظيم، أظنه تقاطع شارع عبد العزيز، مع شارع الحمرا.
أذكر أن مدخل الفندق، قد أهابني لسعته وجماله ولعدد الموظفين على بابه. طلبنا سعادة النائب. صعدنا إلى بهو الطابق الأول. هالني منظر السجادة الحمراء، من أول الدرج، إلى عمق البهو الواسع. سرعان ما أطل علينا سليمان بك، بلا موعد. وبلا هاتف مسبق. كان اللقاء معه مؤثرا. أضفت إلى إعجابي بشارع الحمرا وقبله بشارع فردان، شدة إعجابي بشخصية سليمان بك، وهو يتوشح عباءة زعامة بكوات عكار، ولا يخلعها عنه لا في الليل، ولا في النهار. لأنني كنت رأيتها على كتفيه، في زيارة سابقة له بصحبة والدي، إلى دارته في الحوشب، فوق سهل عكار.
مضت بي سنوات كثيرة، حتى عدت هذة المرة إلى شارع الحمرا، بصحبة ظلي. كنت أريد أن أتسجل في كلية الحقوق في الصنائع تشرين الأول-1969. هالني منظر درج كلية الحقوق. كانت مذكورة في كتب التاريخ، إنها تعود لكلية الحقوق في بيروت، زمن الرومان. منظر الأعمدة. منظر حديق الكلية. منظر حديق الصنائع. أنهيت تسجيلي، وأسرعت إلى وزارة السياحة. إنطلقت سيارة الأجرة بي إلى الأونيسكو، لرغبتي في التسجل في كلية الآداب. إختفت الترومواي من الطريق. هكذا علمت، بعد زيارتي الثانية لمدينة بيروت. بعد عقد من السنوات، أو يشبه العقد. زادت العمائر الضخمة. زادت عظمة شارع فردان في عيني. كبر معي، وكبرت معه. صرنا أخوين: أتذكر كلما مررت بفردان، موقع قيادة شرطة بيروت. ومكتب العميد سعيد بك الحسن.، حين رأيته عظيما، بعين واحدة. حين رأيت مشهد الدولة بعين صغيرة واحدة.
إلتزمت بدراستي في كلية الآداب، وكنت أعود إليها من “طيرفلسيه” في الجنوب، لأنني كنت قد عينت في العام نفسه، مدرسا في مدرستها الرسمية. كنت أدرس فيها أربعة أيام، وأنزل للدراسة في كلية الآداب ببيروت، لثلاثة أيام.
جمعتني صحبة الدراسة، بثلة من زملاء الدراسة في كلية الآداب. كنت أنام عندهم. وأسهر معهم، وأنزل إلى شارع الحمرا بصحبتهم، في الليل وفي النها: مصطفى بطش، وأحمد يوسف، ومحمد سلطان وعصام الأيوبي، وأحمد فوال. وإبراهيم عكاري. وكان شارع الحمرا يعظم في عيني، يوما بعد يوم. فأراه يمتد لناظري، ولا أحيط علما بآخره ولا بأوله. ولا أعرف من أين يبتدئ. ولا أعرف أين ينتهي. كنت أذهب إلى السينما فيه مع زملائي. ونعود مشاة آخر الليل إلى الأونيسكو للنوم. ما كان النهار عندنا إلا قطعة من الشمس. وما كان ليل شارع الحمرا، إلا ظلا للشمس. ما كان ليل شارع الحمرا يخلع معطفه بسهولة للشمس. كان يشع بأنوار طوال الليل، مثل “عروس من الزنج عليها قلائد من جمان”.
عدت إلى شارع الحمرا بعد تخرجي من الجامعة اللبنانية، لأزور مركز دراسات فلسطيني، قرب محطة السادات. كان ذلك في العام1974. كنت أتنقل بين شارع بلس والسادات ومنطقة اليسوعية، لزيارة المكتبات. كنت ألتقي بنزار قباني في مكتبه ببناية اللعازرية تحت رياض الصلح. كما ألتقي ب”عزت دروزة” في مكتبه بمركز الدراسات الفلسطيية قرب الجامعة الأميركية. كذلك كنت ألتقي بالشاعر خليل حاوي في حديقة الجامعة الأميركية، حين كنت أزور مكتبتها . وكنت كذلك ألتقي بالشاعر أدونيس، في مكتبة رأس بيروت، في شارع بلس. أما محمود درويش، فكنت أزوره في مكتبه في مركز دراسات فلسطيني في شارع السادات. وكنت أسلم عليه في مقهى الهورزشو، حين كنت أمر بشارع الحمرا. وصالات العرض فيها، التي تدهش المارة.
بعد حرب السنتين، عدت إلى شارع الحمرا، لأتابع اللقاءات مع دور الصحافة، التي أنشر فيها مقالاتي. ولأزور دور النشر ودور الطباعة ودور التوزيع. كنت أقوم بذلك أسبوعيا. فأتعرف على شارع الحمرا أسبوعيا. كنت في هذة السنوات، أتردد على مقاهي شارع الحمرا. وأضرب المواعيد فيها: المودكا والبروباغندا، وكافيه دي باري، وفي لينس، في فردان، والوينبي و الهورس شو والكريباويه، والسيتي كافيه في آخر شارع السادات. وألتقي بمن كنت تعرفت إليهم في مكاتبهم، في جريدة النهار وفي جريدة السفير وفي جريدة الحياة. كنت معجبا بهؤلاء جميعا لعملهم في شارع الحمرا. وكنت كذلك أغبطهم لإرتياد مقاهي شارع الحمرا، وسكنهم فيه. وكيف أنهم يصلون باكرا إليه. وكيف أنهم يقطعون أوقاتهم فيه حتى آخر الليل. تعرفت إلى عصام العبدالله وكوكبة من الأدباء والشعراء حوله، في مقهى عليا. وفي مقهى كافيه دي باري.تعرفت إلى أحمد بزون،و زاهي وهبي. إلى رشيد الضعيف. إلى شوقي بزيع، الذي كنت عرفته طالبا، على رصيف ثكنة فخرالدين، قبالة كلية التربية، فأعجبت بأشعاره مبكرا. تعرفت عن طريقه، إلى الشاعر نعيم تلحوق. تعرفت إلى الشعراء والأدباء: يحي جابر، عماد العبدالله، وعباس بيضون، وحسن داود، ويوسف بزي، وعبدو وازن، وبول شاوول، ومنصور السبع، وعلوية صبح، وحسن العبدالله، وجودت فخرالدين، والمير طارق آل ناصر الدين، وفادي ناصر الدين، وخليل الزين وخيرات الزين، ونهاد حشيشو وحبيب معلوف وخليل الحكيم وإلياس خوري وفيصل سلمان، وفوزي بعلبكي، وحسين حمية. ونوفل الأمين، ود. محمد وهبة، ومحمد الأمين وهيثم الأمين، ومحمد أبو علي، والروائي إلياس العطروني، والباحثة يسرى مقدم. والشاعر الأنيق، عبد الغني طليس. وكثيرين غيرهم ممن هم في قلبي حتى اليوم.
هذا التاريخ الطويل مع شارع الحمرا، أحفزني للسكن فيه، بعد بلوغي سن التقاعد في الجامعة اللبنانية. غير أن “قلة ذات اليد”، هو ما أخر سكني فيه، رغم مشتهاه في نفسي، حتى صيف2017.
إتخذت منذ ذلك التاريخ شارع الحمرا سكنا لي، بعدما عدلت عن السكن في “ميامي بيتش”، أو في باريس. لا تصدقوا إذا ما بحت لكم بسر ذلك: كنت أسير في شارع الحمرا، حين سمعت رجلا بصحبة زوجه، يسير الهوينى أمامي. سمعته يهمس في أذنها، أنهما يسيران في شارع الحمرا. قال لها، بلهجته “غير اللبنانية”: إن شارع الحمرا في عرف السواح العرب، “شانزليزيه باريس”. فقلت في نفسي : وجدتها. عزمت فورا على السكن في شارع الحمرا، أو تحته، حتى شارع المقدسي، والصيداني، وبلس. بناء على نصيحة من العميد المتقاعد محمد علي، والمهندس رفيق الديك الذين كنت أنتدي معهما، ومع ثلة من الأصدقاء، لسنة وأكثر، في مقهى “إستار باك” في وسط شارع الحمرا. فأخذت أقوم يوميا بجولاتي، بصحبة الصديق القديم، نبيل فرج، ونعيم فاعور، ورئيف كرم، لأحقق حلمي، وأسكن في شارع الحمرا.
سنة واحدة فقط، عرفت فيها شارع الحمرا في الليل وفي النهار. كان حقا عاصمة العرب. كنت ألتقي فيه بالسفراء وأمر بالسفارات وبالمراكز الثقافية: الألمانية خلف الوتوات، والبريطانية خلف فصيلة حبيش والفرنسية في تحت شارع الصيداني، بمحاذاة الجفينور. وبمكتبة الجامعة الأميركية في بلس. وبالزائرين وبالسواح. كنت ألتقي فيه بالكتاب والشعراء والممثلين والمنتجين، وبالأطباء وأهل الطباعة والنشر.
في 17ت1- 2018، إنقلب شارع الحمرا رأسا على عقب. أغلقته المظاهرات وأحرقته. كنت أخرج في الليل لأرى بأم عيني، كيف يتهاوى شارع الحمرا من أوله. أمام مصرف لبنان، “بحذاء” أو بمحاذاة الداخلية ، لا فرق. يضرب المندسون في الثورة النار في محاله. يحطمون واجهات البنوك والمقاهي والفنادق . كانوا يحرقون الحاويات. ويحطمون شارات السير. ويقتلعون الإشارات وعلب الحاويات الصغيرة. يحطمون علب الهاتف. ويعتدون على شباك الطريق الحديدية. وكذلك على أشجاره. ويقتلعون الصغيرة منها. يكسرونها أو يحطمونها، أو يقلعونها.
أكملت جائحة كورنا، ما عجز عنه المندسون “الثوريون”. أغلق شارع الحمرا. وسال فيه المتسولون منذ ذلك التاريخ الأليم، مثل الجائحة. كثيرا ما كنت أتعرض منهم للأذى، وأنا أعبر إلى منزلي، في آخر شارع المقدسي. كانوا يتحوطونني. و”يتفون” في وجهي من بعيد، إمعانا في أذيتي المادية والمعنوية. وكثيرا ما كانوا يضرمون النار في الجرائد التي تعودت أن أحملها معي من كشك نعيم صالح. ومن كشك محمود السيد، على غفلة مني. أهرول نحو الصبي الجاني، فيعترضني سائر الصبية ويلأمون علي.
فتح البلد بعد إغلاق طويل، لعام تقريبا. وإعتاد المتسولون على العيش في شارع الحمرا. إتخذوا من الحوائط والسواتر والعبارات والجنائن والأبنية الهالكة، وكذلك من باحات الفنادق والمحال والمقاهي والمسارح المغلقة، ملاجئ لنومهم في آخر الليل. حتى بات شارع الحمرا، مأوى الشذاذ: فتية وفتيات ونساء ورجالا وشبابا، من كل الأعمار. ونزل المتسولين عل حد سواء.
صرت أرى المتسولات في شارع الحمرا، ينزعن أقمطة أطفالهن الرضع، و يرمينها في الطريق بلا مبالاة. غير عابئات بأحد من حراس شارع الحمرا.
غربت شمس شارع الحمرا. صار الشارع التاريخي العالق في قلبي، مثل مدينة عنجر التاريخية، ضربه الزلزال السياسي. رماه أرضا شارعا منكودا منكوبا مثل مدينة عنجر التاريخية، يعيش اليوم “ظلال الغروب”.فهل يتنبه اللبنانيون إلى شارعهم الوحيد، إذا ما قرر أهل الجامعة أن يجلوا عن شارع بلس، بلا رجعة!. سؤال سابق لأوانه، ولكنه برسم القادم من الأيام، حين يصير شارع الحمرا، “الضاحية الشمالية” لبيروت، على حد قول صديق.
د. قصي الحسين
أستاذ في الجامعة اللبنانية.