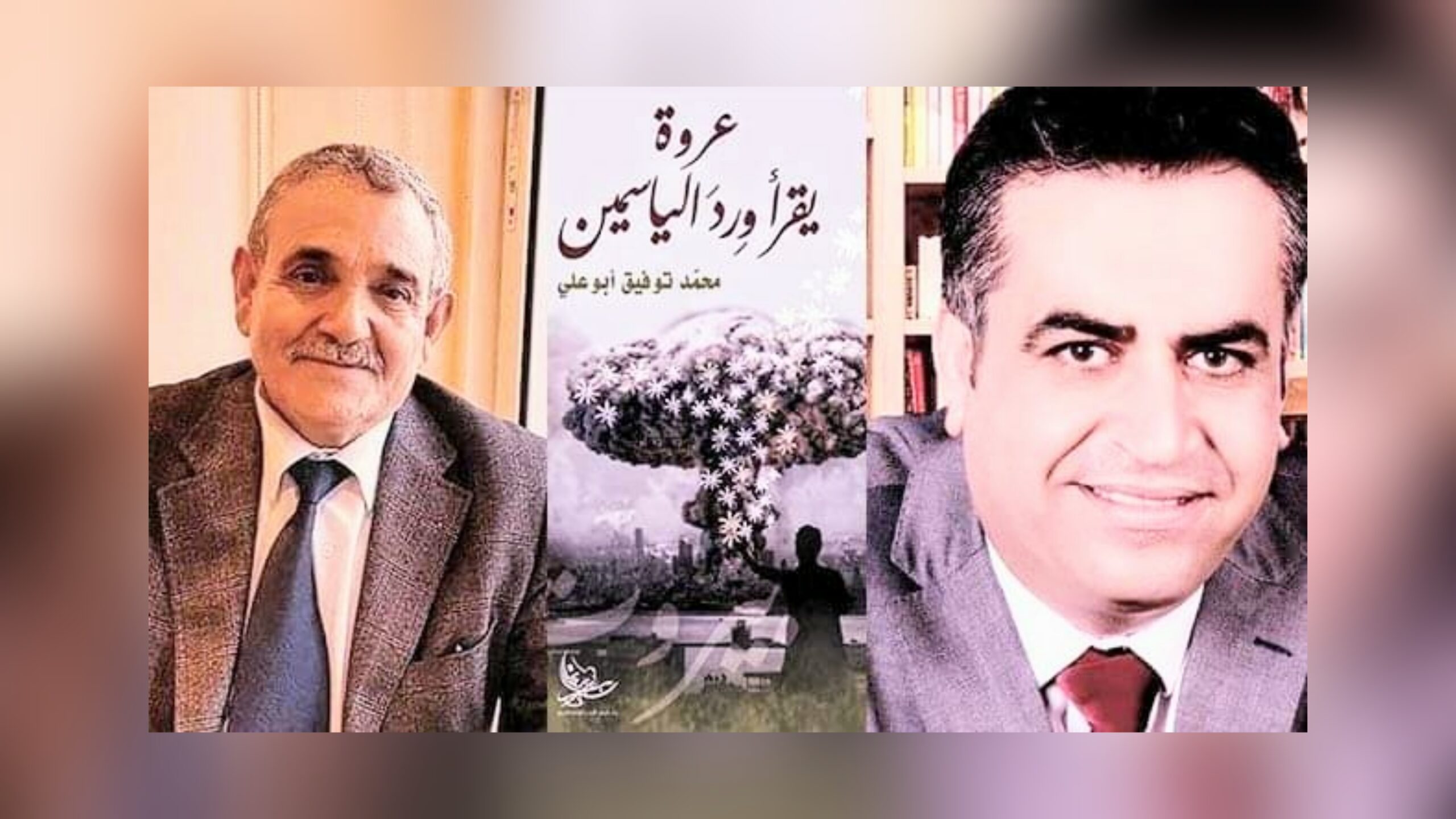يدٌ على القلب ويدٌ على الوطن”
قراءة في مجموعة الشاعر الدكتور محمد توفيق أبو علي “عروة يقرأ وِرد الياسمين”
كتب : الدكتور داوود مهنا (شاعر وأكاديمي)
في مجموعته “عروة يقرأ وِرْد الياسمين” الصّادرة مؤخّرًا عن دار ناريمان للنّشر والطّباعة والتّوزيع، ينشر الشّاعر الدّكتور محمد توفيق أبو علي مجموعة نصوص، تتوزّع بين شعرٍ، وحكايات، وخواطر.
عنوان المجموعة يحيلنا إلى معنى التّماسك والاعتصام بالشّيء، ما يلمح إلى أمرين: أوّلهما أنّ هذه المجموعة يشدّ بعضها بعضًا من أجل استكشاف مكنونات الجمال، وثانيهما أنّ هذه المجموعة فيها دعوة ضمنيّة إلى شدّ العرى والالتحام والاعتصام بحبل واحد من أجل الوصول إلى الخلاص. ولكنّ القارئ الّذي يستبعد اسم الشّاعر الجاهليّ “عروة بن الورد”، يفاجأ مفاجأة لطيفة أنّ “محمد أبو علي” قد لعب لعبة فنّيّة جميلة، إذ حاول تحوير الاسم الأصليّ للشّاعر الجاهليّ، فجاءت الكسرة تحت الواو في كلمة “وِرد” لتذهب بالمعنى بعيدًا إلى مكان إشراف الياسمين، والياسمين يشرف على منابع الجمال الطّبيعيّ، ليأتي عروة ويقرأ هذا الجمال، ولكن هذه المرة بعين حداثيّة معاصرة، بعيدة من العيون الجاهلية. وفي قراءة هذه المجموعة، بوصفها عملًا شعريًّا، يمكن إلقاء الضوء على مجموعة من العناوين، منها:
وجه عروة:
المعروف أنّ “عروة بن الورد” هو شاعر من أشهر شعراء الجاهلية وأكرمهم. كان يقود الصّعاليك في الغارات، ويوزّع عليهم الغنائم، وكان يسرق من الأغنياء لإطعام الفقراء والمساكين، ولا يغزو من أجل السّلب والنّهب، فأضفى على الصّعلكة نوعًا من الاحترام والتّقدير. وهذه الصّفة الملازمة لعروة لم تفارقه في مجموعة “محمد توفيق أبو علي”، إذ راح عروة يحمل هموم الفقراء، إلى أن أصبح اسمه مقرونًا بهم، ومجيئه شبيهًا بمجيء الرّسول إلى قومه. لقد سمت شخصية عروة فوق مستوى البشر العاديّين، وربما وصل إلى مرحلة القداسة بين قومه، لأنّه ذو لمسة إحيائيّة تبعث الشّهداء من موتهم، مبشّرًا بحياة تليق بالحالمين. يقول (الديوان ص9):
من واحة العشق، من آخر الصحراء
إلى أم المدائن
بريد الشوق بين البر والبحر
سليلة الماء والجمر
عروة الفقراء يأتي
يسبقه الحمام
يظلله الغمام
ومن عينيه تهمي دمعة بيضاء
يقرأ وِرد الياسمين
ويقول للشهداء قوموا
هذا زمان الحالمين
سنخيط بالضّوع حلمًا لا يموت
ونخيط للحلم دثارًا
اسمه بيروت.
إذًا، عروة هو المخلّص، وهو الحامي والمدافع، وهو الّذي يقف حائلًا دون الجوع إذ يثور معلنًا عدم انصياعه للقهر والظّلم (ص29):
سلامًا
سلامًا لقيس الفقر يأتي
من خوابي الوجد، من قرع النواقيس، ومن مآذن روح عصيّه
سلامًا له من عروة يعدو نحو نارٍ قرمطيّه
توقظ الشرر الغافي لشمس عربيّه
تكتب للنور تاريخًا… ترسم وجه الحضارة… تُرجع للشرق طهر القادسيّه!
تقع على عاتق عروة مسؤوليّة كبرى تتلخّص في إعادة المجد لتلك الأمّة. فالأمّة العربيّة تغفو في سبات عميق، وهي بحاجة إلى أن تعيد أمجادها الغابرة، ولن تُعاد تلك الأمجاد إلاّ على يدي عروة، ذلك الوجه الوحيد القادر على الوقوف في وجه الموت، وفي وجه الحق المسلوب، بينما الكلّ ساكت حوله لا ينبس بكلمة (ص 56):
كانت الغمامه
وكان عروة نقطة زيت
تطفو فوق ماء الموت
تمتشق الصوت
سوطَ حق وحسامه
وكان الصمت
قحطًا يسافر في جذع الكلام
نعشًا يسامر أحلام الغمام
وصهيلًا يخيط ثياب الرمل أغنية سريّةً
تخشى كوابيس النهار… تغنّي للظلام
فكان عروة حرز أغنية
لعنادل شردتها بوم الخميله
فمضت تخاف يعثر خطوها
وتقتلها القبيله!
وإذ تُعلَّق الآمال على عروة، ويصبح هو الأمل الوحيد للخلاص، يقف مخاطبًا الناس، وتصبح أقواله متداولة مرددة على الألسن، فيعلن موقفه من قضايا الأمة، ومنها فلسطين (ص 73):
عروة قال:
كل ريح لا تحمل القدس لقاحًا
نذيرٌ بسوء المآل
وسموم قاتلة.
سيّانِ: تركب بحرًا
أو تذروها رمال
وأقول: نِعم الرأي ونعم المقال!
ولا تنتهي أقوال عروة وأحاديثه وتوجيهاته وتعليماته في ساحات الحراك، ليصل القارئ إلى نتيجة مفادها أنّ “محمد توفيق أبو علي” قد لجأ إلى شخصيّة عروة بن الورد بوصفها قناعًا، وذلك بهدف التّخلّص من الغنائيّة المباشرة، ودمج صوته في صوت تلك الشّخصيّة، ليضفي على صوته نبرة موضوعيّة شبه محايدة، تنأى به عن التّدفّق المباشر للذّات.

النّبوءة والحلم:
يرتقي محمد توفيق أبو علي في حلمه إلى مستوى النّبوءة، والنّبوءة معروفة في الشّعر، إذ يرى الشّاعر ما لا يراه الآخرون، فيفتح نصّه على الرّؤى والدّلالات والتّأويلات. إنّ محمد توفيق أبو علي يلتزم الهمّ الوطنيّ العامّ، فيرتقي بوطنه إلى مستوى التّأمّل والتّعمّق في الذّات. وإذا كان الوطن يعاني وجعًا، فإنّ الشّاعر يرى أنّ الخلاص آتٍ في الأيام القادمة، ربّما على أيدي الأجيال الطّالعة التي يعلّق الآمال عليها في التّغيير. لا يكتفي الشّاعر هنا بما تراه العين، إنّما يدرك من الأمور أعمقها وأكثرها صلةً بالروح، لأنّه هو ابن هذا الوطن، يعشقه، ويعرفه عن كثب، فتولد علاقة خاصة بينهما، تجعله قادرًا على استكشاف ما تضمره عناصره، وما يخبئه مستقبله (ص 12):
إني أرى همسًا لغيث قادم
فمتى يصير الهمس جهرًا يا غمام؟
ومتى يؤوب الماء من تطوافه؟
ظمئت صحارى الروح، والواحات يعروها السقام.
وعلى الرّغم من الجدب الحاصل في الوطن، فإنّ الشاعر ما زال يرى انبعاث الحياة من الصّحارى. والموت لا يمكن أن يهزم هذا الوطن الذي يعشق الحياة. لا بدّ من أن يهمي المطر لتعود الحياة وتزهر الفصول (ص 14):
إني لأبصر في الصحارى نخلة
تأبى الذبول
وتخيط من أفيائها ثوبًا لزركشة الفصول
إني أرى رغم الهجير غمامةً في القيظ هيمى بالهطول
وأرى نجومًا لا يدانيها الأفول
إني أرى وطنًا يعود إلى الجذور… إلى الأصول
إني أرى وطني الجميل!
وينمو الحلم في بال الشّاعر إلى حدّ التّأسيس والبناء؛ فهو يحلم ببناء مدينته ووطنه كما يشاء شعرًا. ولا غرو إن بنى الشّعراء أوطانهم كما يشاؤون، فالشّعر تخيّلات ورؤى وأفكار قابلة للتّحقّق، والشّاعر حالم آمل، يستشرف مستقبل وطنه الجريح، ويصنع في مخيلته وطنًا بديلًا لأنّه غير قادر على تخيّل جرح الوطن وآلامه. (ص 40):
بيروت قومي من جراحك واهتفي
قسمًا بإنجيل يُجَلّ ومصحفِ
سأصوغ حزني معجمًا يُذكي اللظى
وأصوغ لبنان الجميل بأحرفي
لا شكّ في أنّ لبنان الجديد الّذي يصوغه الشّاعر هو لبنان الإلفة والمحبّة والانسجام بين جميع أبناء الوطن الواحد.
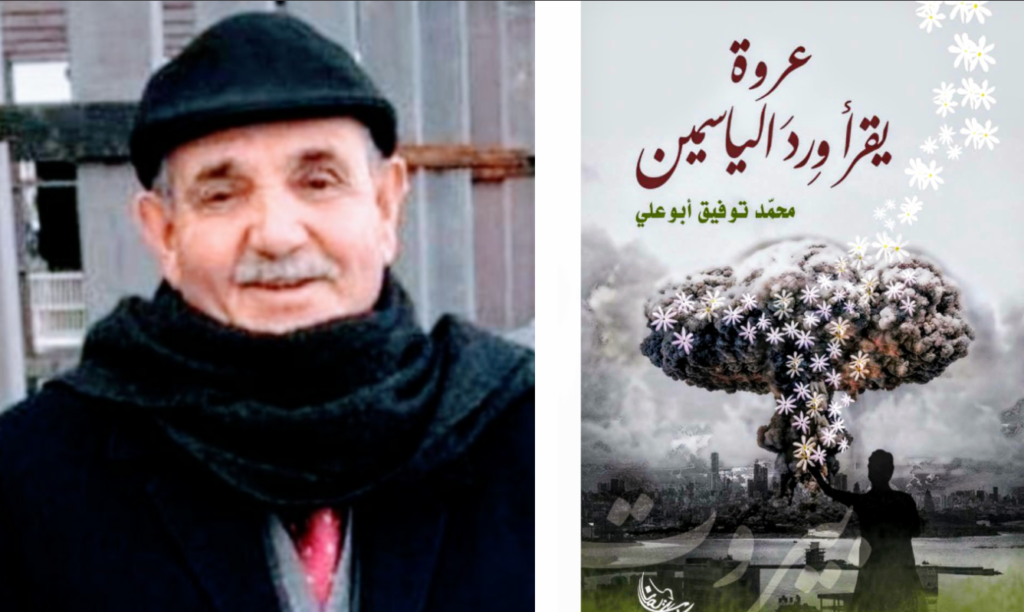
بيروت:
ظهرت مدينة بيروت بوصفها معشوقة العشّاق وشغفهم، راح الشّاعر يتغزّل بها مظهرًا مفاتنها، فهي المشتهى وهي قبلة القبل. وما دامت بيروت جميلة إلى هذا الحدّ، فلا يمكن انطفاؤها، والشّاعر يحذّر من ذلك لأنّ بيروت هي منارة الشّرق، وإذا انطفأت فسينطفئ نور الشّرق كاملًا (ص 16):
بيروت يا شغف العشاق، إن عشقوا
يا وجنة المشتهى، يا قبلة القبل
…
بيروت يا شهقة الأنوار وامضةً
ويا ضماد أسى، في مذبح الملل
إن تطفئوها، فنور الشرق منطفئ
وفي النفير انبجاس القادم الجلل.
وعندما يتحدّث محمد توفيق أبو علي عن وطنه الجريح، تحتشد أمام عينيه عبارات التّعب والأسى والظّلم؛ إنّه يعيش المرارة تلو المرارة، لكنّ صوته لا ينفكّ معلنًا ثورته على كلّ المآسي الّتي تصيب وطنه. يُطلق صرخة لعلّها تدّوي في مسمع ما، لكنّ الدّمار يقطف كلّ شيء جميل، والأعداء يتربّصون بهذا الوطن مدجّجين بما يملكون من أحقاد وظلم وقهر. فكيف للشّاعر أن ينقذ مدينته من تلك المآسي؟ لقد أمست بيروت مقبرة، فأقفل كلّ شيء أمام وجه الشّاعر، والحلم ثوى تحت الرّكام (ص 32):
بيروت – يا حسرتي – أمست مقابرنا
والحلم – يا حسرتي – تحت الركام ثوى
وإذا كانت بيروت جريحة اليوم، فإنّها ستنهض غدًا. والشّاعر يتلمّس أحلامًا للثّورة لعلّها تكون سحابة تمطر ماء يحيي نبات الانتفاضة. يحاول بكلّ ما ملكت يداه أن يكون فرحًا في فضاء المعذّبين. ستنهض بيروت من تحت الرّكام، ويكون جرحها دليلًا لها نحو الحلم الواعد (ص )41:
بيروت يا وجع القصيدة في المرايا الشارده
تحت الركام، ويا جمار الحزن في صمت القبور الواعده
أُوبي لنبكي جرحنا
نبكي قليلًا، ثم نطمر دمعنا
قرب الأحبة، عله ينمو غدًا
شجرًا يُظلل في الهجير صبابةً
للحلم، للوعد الصبور، وللأماني العائده.
وبيروت هي المدينة الوحيدة الّتي تشير إلى الحياة، هي منارة المدن، لا تعرف الموت ولا الدّمار. كانت وستبقى ضوءًا ينير فكر الكون علمًا ومعرفة (ص 81):
بيروت لا تغضبي
تكسرت المرايا
لم يبق غيرك مرآة تشي سر الحياة… تشي ما يكره التابوت
لم يبق غير وجهك ثديًا يرضع الشمس
ضوءًا لا يموت
بيروت
مثقلةٌ بالحب أنت:
انظري سلمان… أبا ذرٍّ… صور وصيدا… أجراس قيامتنا، وطرابلس الفيحاء وأمي، قد رسموا الحلمَ سؤال
في مدارات الرمال
وحدك يا بيروت جواب
أجيبي… يَعْنُ المُحال!
وعند استحضار الفجيعة الّتي حلّت ببيروت وأوقعت فيها الدّمار والخراب، لا بدّ من استحضار مدينة “كربلاء” الّتي ترمز إلى أعظم فجيعة جسّدت الظّلم بأبشع صوره. فبيروت وكربلاء تعانيان الوجع ذاته، وهمومهما مشتركة، لهذا، وجب إقامة مراسم الحزن سويّا لأنّ العدل في الكون قد شنق، وبسط الظّلم سلطانه، وليس من عزاء سوى بموت الطّغاة الظّالمين (ص 105):
بيروت نادي كربلاء
قولي لها: جمع الجوى أوجاعنا
هيا تعالي كي نقيم معًا مراسم حزننا
بمشانق العدل التي تغدو فضاء قصيدة، ترنو إليها لوحةٌ فوق الجدار
تروي لذيّاك الفضاء
وجع الدماء
تحت الدمار
وتقول للأحرار في وضح النهار
يا قوم إن عزاءنا موت الطغاة، فموتهم نعم العزاء.
تبدو الهزيمة واضحة هنا، فالمدن العربية تكاد تكون متشابهة في وجوهها، والواقع المأزوم يلاحق الشّاعر، ويرى أن البّكاء واجب على تلك المدن المقهورة والمظلومة. وهذا البكاء سيدوم طويلاً لأنّ البلاد العربية تعاني الأزمات والانكسارات والهزائم المتتالية، والمجتمع العربي واقف كالوتد لا يحرك ساكنًا، ولا ينتفض على واقعه كي يعيد المجد العربيّ التّليد. والشّاعر يعود مرّة أخرى مكابرًا على نفسه، معلنًا مرّة أخرى أن بيروت ستقوم من تحت الرّكام. ولكن السؤال يبقى: ما حال تلك المدينة التي تتلقى النكسة بعد الأخرى، وتقوم مرة بعد الأخرى من تحت الركام؟ هل يبقى وجهها في المرايا ناصعًا، أم تشوهها أحداث الزمن؟ ما زال الشاعر يحلم بأن تنهض بيروت وتعود منارة للشرق.
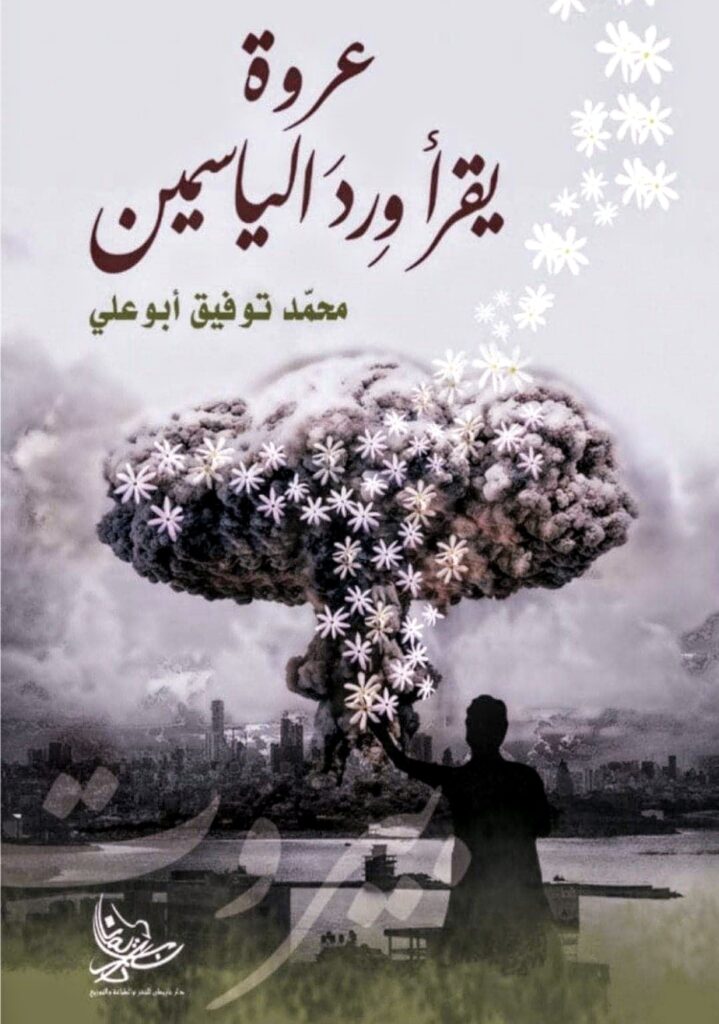
فلسطين:
الانتماء العربي واضح في شعر محمد توفيق أبو علي، فهو يرفع شعره إلى كلّ مظلوم في هذا الوطن العربيّ. إنّه يتكلّم بلسان المعذّبين في هذا الوطن، والمقهورين الّذين يعيشون الظّلم والمرارة. لقد نظر إلى هذا الواقع، فرأى القضيّة الفلسطينيّة، والحروب والويلات والدّمار والخراب. وقف حائرًا إمام هذا الواقع، لا يدري، هل يقف مستسلمًا يائسًا، أم يطلق صرخته الشّعريّة في وجه هذا الظلم الجائر؟
وكانت فلسطين نجمة هذا الواقع، نجمة معذّبة، حضرت حضورًا بارزًا في شعر محمد توفيق أبو علي، بوصفه شاعرًا ملتزمًا قضايا الأمة، فراح يسجّل المحن السّياسيّة الّتي شهدتها تلك الأرض الفلسطينيّة تحت وطأة الاحتلال. من هذا المنطلق، ظهرت العاطفة القوميّة والوطنيّة والعربيّة مشعّة لدى محمد توفيق أبو علي، في قصائد عديدة، بدت مرآة أحوال القضيّة الفلسطينيّة والشّعب الفلسطينيّ. وقد ظهرت في شعره صرخة الألم والثّورة ضدّ الاحتلال والاستبداد والظّلم، فبرزت القصيدة منبرًا صارخًا للدّعوة إلى الجهاد والكفاح، من أجل دحر الاحتلال وإنقاذ فلسطين من رجس الأعداء. إنّ القضيّة الأساس لدى الشّاعر هي القضيّة الفلسطينيّة، ودم الشهداء لن يضيع سدى (ص 15):
سأقول في وضَح النهار:
القدس صوتي والصدى
وأقول إن القدس في فقه الدماء قضيتي
… ونُحاتنا الشهداء قالوا: لن يضيع دمٌ سدى
ونحاتنا قالوا فلسطين العصية دائمًا ممنوعة من صرف أسواق النخاسة والعدى.
وفلسطين هي الّتي سيجتمع فيها الشّمل، ستتوحّد الفصائل، ويتوحّد أبناء فلسطين يدًا واحدة في مواجهة الاحتلال، ولن يتقاتل أبناء الوطن الواحد، بل سيقاتلون الاحتلال. فالتّباعد الحاصل بين أبناء فلسطين اليوم، لن يكون غدًا سوى لقاء انسجام، وتكون فلسطين هي الأم الحنون الّتي تجمع جميع أبنائها في حضنها الجميل الدّافئ المطمئنّ (ص 50):
فيا رمل، كفاك تشرب دمعي
كأس نشوة وهوًى
رغم الكيد، ورغم الويل
سنجمع شمل الفاء والنون
وستبقى فلسطين لنا أمًّا
نعم أمًّا حنون.
وحين يصل عشق الشّاعر لفلسطين إلى منتهاه، فإنّ ذلك العشق يتمكّن من الشّاعر تمامًا، ليصبح مستحوذًا على قلبه وعقله، فيطلق دعوة وصرخة ونداءً إلى أن تكون القدس هي الحبيبة الوحيدة، والتّفكير يجب أن يتّجه نحوها فقط. إنّ فلسطين هي بوصلة الحبر، وكلّ حبر لا يعرف فلسطين يبقى حبرًا عقيمًا لا يلد قصائد يانعة (ص 51):
ازرع في قلبك قدسًا
في عقلك قدسًا
ترجم معجمك الرملي إلى لغة القدس
وأعد للقرص الشاحب معنى الشمس
ناج فلسطين، وقل:
أرشديني إلى الحبر
لنعيد كتابة الجمر
ضفائر ولهى
عشًّا لعصفور طريد
حبل مشنقة لخفاش يغني
يرتجل المسافة بين ثدي وأحلام الوليد
ناج فلسطين وقل:
فلسطين المرايا السحيقة تحملها الأزمان
تأوي إليها طفلة ترسم وجه أبيها
حرفًا يكتب فوق النار المسعورة وهج الطين
دفء الذاكرة المسجونة في حد السكين
وكتابًا أزليًّا يختصر العشق ولا يعرف درب النسيان.
وإذا كان الظلم الذي تتعرض له كل من فلسطين وبيروت متشابهًا، فمن الطبيعي أن تتحد فلسطين مع بيروت من أجل كشف وجه المعتدي القاتل والمغتصب، وافتضاح أمره (ص 20):
هي ليلى العامرية
تكشط عن وجه قاتلها
ورق التوت
تتجلى تارة في حجر
يقذفه الصبية من سور فلسطين
تارة في قمر يغشاه وجد شاسع وحنين
وطورًا في بلاد مترامية الأطراف، واسعة المدى، تدعى… بيروت.

المرأة والحبّ:
المرأة عند محمد توفيق أبو علي هي الرّجاء الدّائم، هي ضرورة في الحياة، وحب لا يزول. هي حلم متخيّل وإحساس مبتكر. وإنّ رؤية محمد توفيق أبو علي إلى الحبّ هي رؤية صوفيّة تقديسيّة، فالحبّ هو الإحساس والسّموّ المطلق، هو النّور والوضوح والحقيقة، وكلّ ما عداه في الكون هو الشّكّ. يمنح الشّاعر الحبّ الشّكل الوجودي الأسمى، للدّلالة على العظمة حينًا، والوفاء والتّصوّف الرّوحيّ والأنس الوجوديّ حينًا آخر (ص 127):
أحبك ذاك نوري
وكل ضجيج ضوء فهو شكُّ
أحبك، جهر سري
وإفكٌ ما خلاه بلى… وإفك!
ويلجأ الشّاعر إلى تصوير حالته الشّعوريّة عبر الشّذرات الرّومنسيّة المشتقّة من حقل الحبيبة وحقل الطّبيعة. فالمفردات زاخرة في توصيف جزئيّات الحالة، ممزوجة بالإحساس الصّوفيّ من خلال الشّعور بالمثيرات الجماليّة والطّبيعيّة، ليزيّن بها نصّه الشّعريّ، متلمّسًا جمالها في عمق معاناته. وبالنّظر إلى عيني الحبيبة، يرى الشّاعر فيهما مورده الشّعري، فالحبيبة هي الملهمة الّتي يتّكئ عليها الشّاعر حال الكتابة. وهنا ينطلق الشّاعر في رحلته الرّومنسيّة الطّبيعيّة، فينتشر الضّوع مترنّحًا، وتزهو الخمائل، ويعيش الشّاعر حالته الصّوفيّة الخاصّة لتتّحد صورته مع صورة الحبيبة، ويصبحان واحدًا. وذلك الحبّ هو الحبّ الطّاهر البريء، المقدّس المصان، الّذي يتلقّى الرّعاية اللاّزمة والأجواء المناسبة، فينمو كما ينمو الطّفل في حضن أمّه. (ص 112):
وِرد تردده حروف قصيدتي
عيناك؛ فالإلهام صار تكيّتي
وترنّح الضوع الهجير بوردة
فزهت بضوع الحب كل خميلة
ومضيت انشد في المرايا صورتي
في واجدٍ، فرأيت وجه حبيبتي
فرشفت منه رحيقه وغوايةً
تهدي الفؤاد إلى سبيل حقيقة
وعرفت أن الحب ينمو بيننا
كنماء طفل في رحاب أمومة.
ويصل الشّاعر إلى حالة من الوجد الصّافي حينما يصوّر ذاته مع الحبيبة كأنّهما اتّحدا في غيمة تذوب في المطر. وهذا الذّوبان هو مصدر حياة ونماء للأرض إذ يهميان في حالة انسجام تامّ، إلى أن يصلا إلى حالة من السّكر الرّوحيّ (ص 149):
كأننا غيمة يقتاتها المطر
نهمي كلحن غفا من وجده الوتر
نذوب شوقًا وتهيامًا كقافية
رويها من دوالي الحب يعتصر
وقد يرتقي الحبّ لدى الشّاعر إلى مستوى أعظم، وهو حبّ الإنسان لأخيه الإنسان بشكل عامّ. وفي دعوة ضمنيّة إلى اتّحاد الكرة الأرضيّة بكاملها تحت اسم الإنسانيّة، يُطلق الشّاعر صرخته إلى العالم أجمع، داعيًا إلى نبذ الخلافات والأحقاد، والتّحلّي بنكران الذّات، والتّطلّع إلى الآخر (ص 104):
ما أحيلى الحب
ما أحيلى الحب يابسة وماء
وِردًا ترتله الشمس صباح مساء
فوق البحر
حين يعصف الموج
وتربدّ أنواءٌ
وصلاة لكسوف
حين تعشي النور ظلمات المدى
ويغترّ هجرٌ
وتختال النوى…
فلتخشع بالنور الأمداء
وليدرك هذا الطين سلالته
ولتخلع كرة عنها/
أقنعة الأسماء.
وهكذا يرسم محمد توفيق أبو علي لوحته الشّعريّة رسمًا فنّيًّا موحيًا، يعتمد دفق الصّور الجماليّة في منحاها التّشكيليّ الوصفيّ، لتبدو اللّوحة فنيّة ترسيميّة مدهشة لتلاوين الحبّ من جهة، ومن جهة ثانية يقدّس الشّاعر الحبّ ليعبّر عن سموه الرّوحيّ وحيازته المطلقة لما يكتنزه الحبّ من جماليات، فهو زورق العاشق الذي يصله إلى الحبيب ليتواصل معه جسديًّا وروحيًّا.