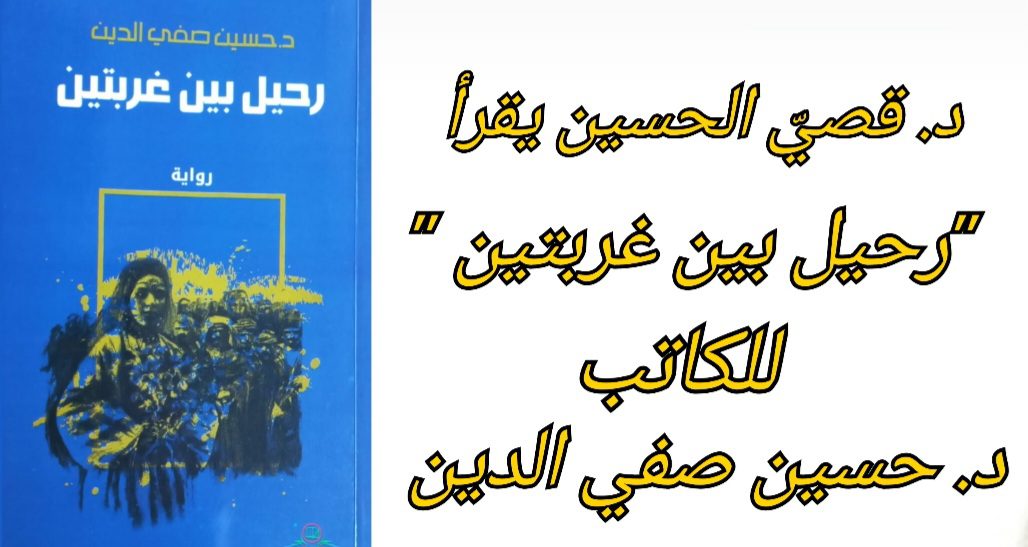رحيل بين غربتين
“كان يقف على ضفة الدردنيل متأملا البواخر العابرة، عله يرى شيئا يذكره بوطنه، يوما بعد يوم دون جدوى. وعند الغروب يحمل أثقاله عائدا إلى موعد مع يوم آخر. ويستمر الإنتظار في غربة قاسية.”
كثيرون من الأطباء والمهنسين. ومن علماء الإجتماع. ومن القادة العسكريين. ومن الشعراء والمربين، يتحولون في برهة صفاء ووجد، إلى روائيين حقيقيين. يخترقون الحاجز الفاصل، بين حياتهم العملية ومهنهم التي يشتغلون فيها، إلى حقل الرواية أو الشعر أو الرسم، أو الموسيقى، أو المسرح والسينما. يتحولون أذا، إلى واحد من هذة الفنون أو اكثر، للتعبير عن شغفهم. يشعرون في لحظة ما، أن الفنون التعبيرية تليق بهم أيضا. فيقصدونها لا للتجمل بها، بل لأنهم يجدون فيها الأوعية الصالحة لصب كل خبرتهم وكل معانتهم في حياتهم. بل لصب كل ثقافتهم أو بعضها، في قولب فنية مخلدة.
“د. حسين صفي الدين. رحيل بين غربتين. دار الإنتشار-بيروت 2024″،
هو واحد من هؤلاء الذين يخلون في ساعات الوحدة مع النفس، للتأمل والكتابة والتحرير. يشاركون بعقولهم وثقافتهم، أهل الإختصاص، في الفنون التعبيرية.
” كل رغيف يأكله الفلاحون مجبول بعرقهم وبعذابات الفلاحين مئات السنين التعبة.”
ولا غرو، فالدكتور حسين صفي الدين، له تجربته الطويلة، في الفلسفة وفي الكتابات الفلسفية والإجتماعية. فعلى الرغم من إختصاصه في الطب وطب الأسنان، تحول إلى الدرسات الأكاديمية والجامعية. وهو ها هنا ، نراه يتحول إلى التجربة الروائية. شأن آخرين كثيرين. يضعون في عالم الرواية، إبداعهم الآخر. ويصوغون فيه ثقافتهم ونضجهم ورؤاهم في شؤون الحياة وفي حقولها الكثيرة.
” قد يكون الميل إلى إذلال الذات، إلى الخضوع للنهب والإستغلال الضعف إله مقيم بين البشر.”
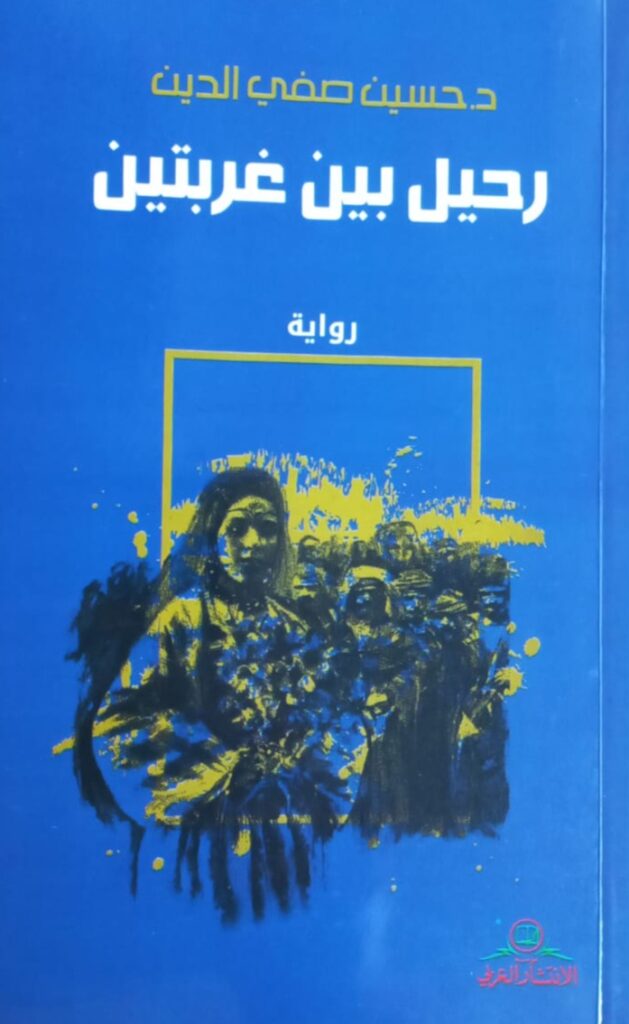
يذهب د. حسين صفي الدين في عمله الروائي هذا الذي بين يدينا: “رحيل بين غربتي”، لقراءة تاريخ جبل عامل، وهو على مشارف القرن العشرين. يصور حياة الناس ومعاناتهم اليومية، مع الإقطاع. ويصور أيضا، إرتباط هذا الإقطاع بالإستعمار التركي، وكيف كانت تقوم بينهما شبكة من العلاقات، التي أضرت بحياة الناس طيلة أربعماية عام. وقد زادت ضررها الحرب التي إنغمس فيها الأتراك. فصاروا إلى التجنيد وحمل الشباب على ظهور السفن، إلى الجبهات. مما كان يهز جنبات الحياة الإجتماعية.
“يلعن أبو الحرب وأصحابا… يلعن هالإيام، لو بموت أنا مش أحسن لي… شو بدي إحمل تأحمل… “
لا يبالغ د. حسين صفي الدين، روايته: “رحيل بين غربتين”، كعادة الروائيين الذين يريدون تزيين الرواية بالغرابة. إختار المنهج الواقعي، ليحاكي أوضاع الناس. وليكون أقرب إلى حياتهم الإجتماعية والواقعية. فكان يصف إكثر مما يتأمل. وكان يتحدث، أكثر مما يتفلسف. وكان ينقل الأوضاع كما هي، صورا واقعية تراجيدية بائسة، لأنها كانت في الأصل، على هذة الصورة الحقيقية المؤلمة.
“لم تكن مهمة الحاجة بالمهمة السهلة. خصوصا وأن وقع الخبر عليها، كان مدمرا. كمن يقنع الآخر بالذهاب إلى الموت. أو يدعوه إلى دفن حياته بيديه.”
تحدث د. حسين صفي الدين، عن تجربة شباب جبل عالمل مع الحب. وعن تجربة صبايا جبل عامل مع الحب. تماما كما تحدث عن تجربة الحب نفسها في المكان والزمان، وكيف كان الناس ينظرون إليها. وكيف كان الأهل يتعاملون معها. فيعيد إحياء مشاهدها لعيوننا وقلوبنا، ويجعلنا نرى بدقة وبعمق، ما كان يجري مع العشاق ومع أهلهم، في ظل الإقطاع المهيمن على البلاد، مدعوما من السلطة التركية.
“وداع الأهل والضيعة كان مؤلما لأمينة هي التي لم تغادر القرية مرة. ولا تكاد تعرف سوى تفاصيل منزلها وحقول الضيعة.”
يصور د. حسين صفي الدين العشاق في غربتهم النفسية، في ظل حكم إقطاعي، يريد إشباع غرائزه كلها. فلا يرعوي، بعد إبتزاز الناس، في أموالهم، عن إبتزازهم في أعراضهم، والإعتداء على شرفهم، وإنتهاك الحرمات بغرائزه الجنسية الوحشية.
” … حياتنا كلها نقضيها في المساومة، بين مبادئنا ورغباتنا والواقع.”
الغربة الأولى، التي يتحدث عنها د. حسين صفي الدين، هي حياة الناس نفسها، تحت حكم الإقطاع. فلا يدع جانبا من جوانبها، إلا ويعرضها، ويشرحها. إلا ويصورها بكل عنفها، أمام عيوننا. فنرى الجانب الآخر من حياة الناس في جبل عامل أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وكانه قطعة من العذاب النفسي والإجتماعي والقهري، يغري بهروب الشباب، أكثر مما يجعلهم يتمسكون بالوطن.
“هجمات موجات الجراد كانت كثيفة ومستمرة… تغير وجه الضيعة. لا تكاد ترى عشبة أو شتلة. وأغصان الشجر باتت بلا أوراق. أصبحت عارية كما الحقول والحدائق.”
ولا شك أن د. حسين صفي الدين، كان يتمتع بأسلوب سلس في وصف جميع الأحداث الجارية، في مجتمع جبل عامل. فهو إبن بجدتها، على هذا الصعيد. وبحوزته جميع الأدوات المعرفية، التي تحيل الوقائع الجارية، إلى منظوماتها التي إندفعت منها.
” وعندما بدأت أحوال القرية تعود إلى طبيعتها، كانت الحرب العالمية الأولى قد بدات. وكانوا على موعد مع مصيبة جديدة، ومعاناة طويلة.”
ينتقل د. حسين صفي الدين، إلى وصف حياة الشباب اللبناني المجند على جبهات القتال. ويطول معه الحديث، عن وصف عذابهم وآلمهم. وعن وصف الغربة هناك التي أوقعت بهم، بعدما كانوا قد حملوا بين أفئدتهم، صور وعذابات غربتهم الأولى بين أحضان الوطن.
” وكان لمصطفى كمال تأثير كبير في قلب الأوضاع. فقد رفع معنويات الجنود، فيكفي وجوده ليشعر الجنود بالثقة.”
يكشف د. حسين صفي الدين عن جميع ألوان العذاب المهين، للشباب اللبناني المجند على الجبهات. وتكون منه إلتفاتة سانحة، للإطلالة على المجتمع هناك وأحواله القاهرة، في ظل الحرب التركية اليونانية. ويقدم لنا لوحات ومشاهد، عن جميع أنواع المشاهد الفظيعة التي كانت جارية في المدن التركية، وعلى الجبهات العسكرية.
“وداع عبد الباسط لأهل البيت كان مؤثرا. فعانق صديقه بقوة. وشكر بكل إحترام زوجته. وهما تمنيا له التوفيق والنجاح في عودته إلى وأهله.”وطنه
د. حسين صفي الدين، نجح في نقل الوقائع بكل أحاسيسها القهرية للناس، في الغربتين: الغربة داخل الوطن. والغربة في البلاد التي رحل إليها المجندون اللبنانيون، في سفر برلنك، وإنغمسوا فيها بصورة إجباربة. فكانت المعاناة أشد وأدهى.
” إكتشف عبد الباسط في تلك اللحظة أن الزمن فعل فعله، بثباته المعهود”.
ينتهي د. حسين من رواية قصة حب، بين غربيتن، إلى التأمل والحكمة والفلسفة. خلص إلى القول: إن الموت هو المعلم الأول لنا. وهو يدفعون للحياة وللعمل بقوة أعظم. على الرغم من ثقله المادي والنفسي علينا. يعلمنا د. حسين صفي الدين، أن نكون أقوى مع تجربة الموت، لأن الحياة للنهوض وللقيامة.
” كأن الموت كان نافذة لإستعادة الحب الذي حجب عنه. وكأن الموت حطم الأغلال التي قيدت عبد الباسط لسنوات. إنه الموت الذي أعطاه حريته من جديد.
فهل نحب مرة؟ مرتين؟ أو أكثر؟”.
د. قصي الحسين
أستاذ في الجامعة اللبنانية.
 د. قصيّ الحسين
د. قصيّ الحسين