كتب نعيم تلحوق في العدد الثالث من مجلة ” علم المبدأ ” مقالة بحثية حول ما ورد في كتاب ” فيزياء الإيمان ” جاء فيها :
بعد مصالحة العلم مع الفلسفة والشعر
كتاب “فيزياء الإيمان” يؤكد مصالحة العلم مع الدين
-×-×-×-×-
يصرّح بعض العلماء على وجود نظرية فيزيائية جديدة نتيجة تطوّر نظرية آينشتاين يظهر فيها مستوى معين من الحقيقة ، والذي يعتبر مرادفه في الدين هو الله -حقيقة ما تمتلك كل علائم الألوهية ، يسميها غ.ي شيبوف “العدم المطلق” ، والبعض يدعوه بالمطلق باعتباره لا محدودياً وأبدياً للطاقة الذي يعطي الحياة لكل ما هو موجود تتولّد عنه الأفكار، (الفيزيائي الأميركي إي. ميرتون).
إن كتاب فيزياء الإيمان للكاتبين ف.يو.تخيبولاف ،و ت.س. تخيبولاف يشعل الصراع على مفاهيم نرفض تصديقها ، مع أن الكتاب علمي وبحثي وأكاديمي ، وينطلق علمياً من تجارب ووقائع وأحداث كان لها الدور الحسي في نقل التصورات والتهيّؤات البصرية إلى أفكار علمية ثم إلى ملامسة منطقية لمعادلات بُنيت على العلم في سبيل الوصول إلى سرّ الكون، أو الله ، وكأنني لا بد لهذا الكتاب أن ينتشر بين الناس كأساس إنطلاقي لإزالة العدائية بين العلم والدين ، سيما بعد الصراع الطويل الأمد بينهما…وقد استعنت بشواهد وأمثولات خارج الكتاب ، لأثبت أن الصراع ليس بين العلم والدين فحسب ، وإنما بين العلم والعلم نفسه، وبين العلم والفلسفة ، والعلم والشعر أيضاً…
بعض الأفكار التي تؤيّد الفكرة التي بُني عليها الكتاب ، والتي تؤكد غير مرة أن مصالحات كثيرة تبدأ بين العلم والدين والفلسفة والشعر وأن الكون غير متروك لنا ، وإنما هناك من يديره ويحافظ على معناه ، لنبتكر به المعنى من وجودنا، عبر فتح طريق للإعتراف بالعالم الباطن من قبل العلم ، إنه العالم الموازي لعالمنا الفيزيائي والذي يدفعنا إلى فتح ممرات بين هذين العالمين المتوازيين بينهما.
بين العلم والعلم
حاز العالم الإنجليزي جوزيف طومسون الفائز بجائزة نوبل للفيزياء عام 1906 ، وذلك لإثباته أن الإلكترونات تسلك سلوك الجسيمات المادية…ثم جاء بعد ثمانية وعشرين عاماً (اي في العام 1937) إبنه جورج طومسون ليحوز على نفس الجائزة أيضاً ، لكن لإثباته أن الإلكترونات تسلك سلوكاً مَوْجيّاً ما يناقض نظرية والده …
إنه التطور التاريخي للعلم والذي هو تجريب يتحوّل إلى معرفة حين ينجح السياق العلمي؟..ما يفيد أن الخطأ لا يلغي الصواب…وإنما يعني أن الحياة عليها أن تكثر تجاربها كي تصيب…
إذاً ، العقل هو مساحة العلم الوحيدة كي ننقذ الكوكب من الدثار، وهو إثبات أكيد أن النظرية العلمية يبقى الشكّ ديدنها إلى حين تثبت إبداعها ونجاحها لتخلق مع مرور الوقت…
بعد أقل من ثلاثين عاماً ، بين الأب وابنه ، يبحث العلم عن تحديد ماهية المنطق في المعادلات الرياضية والفيزيائية لتقترن الصورة بالفعل ، والخيال بالواقع ، والفكرة بالتجريد ، والوهم بالحقيقة…إن عبر نظرية آينشتين النسبيّة ، أو عبر الإفتراضات العلمية التجريبية، أو سلوكيات العقل البشري…
بين الفلسفة والشعر
هذا الأمر يحيلنا إلى سردية الفلسفة والشعر ، فالفلسفة تسأل “ماذا تقول” ، والشعر يحيل السؤال إلى صورة جمالية ،”كيف تقول لماذا” ، والمسرح يشخّص الصورة إلى “أين ومتى” تقول اللماذ والكيف؟!
إذاً ، المعادلة الأدبية تذهب إلى نظرية علمية ، وهي منطق إفتراضي يبني تصورات جديدة تستمد حركتها من الحياة أو الوجود ،فالخيال في العلم يساوي الوحي في الدين ، يساوي الفكر في العقل، يساوي الشعر في الجمال…يعني أن الوحي إله، والكلمة نص، والعقل قبول…
إذاً ، يبحث الفيلسوف عن الحقيقة المطلقة أما الشاعر فيبحث عن الجمال المطلق، لأن الاول لا يقبل بالحقائق الجاهزة ، وإنما يتخذ الشك سبيلاً الى اليقين… أما الشاعر فيكتفي بأثير نجواه ويبحث عن صور جمالية واقعية تسكن قلبه وروحه ، أو متخيّل يتنازعُ لاوعيه…وكلاهما نسبي بالتأكيد…
حين التقى العالم الشهير إينشتاين صاحب النظرية النسبية بفيلسوف الهند الكبير طاغور في ألمانيا عام 1930م ، جرى بينهما حديثٌ مُعمَّق هذه خلاصته :
قال آينشتاين : الواقع نسبي و الحقيقة مطلقه …
فردّ عليه طاغور : “بل كلاهما نسبي ، لأنك إذا أنكرتَ الواقع ستنكر الحقيقة ، والعكس صحيح ، فالكون بأكمله بداخلي وأنا بداخل الكون ، ولا يوجدُ جمال إلا بوجود معجب به ، ولا توجد حقيقة إلاّ بوجود مُصدّق لها “.. فانبهرَ أنشتاين من هذا الكلام العبقري لطاغور وقال له : قبل لحظات كانت نظريتي ناقصه ، وأنتَ الآن أكملتَها بإثباتك أن الحقيقة ليست مطلقه … هنا اجتمعت الفلسفة بالشعر ، اجتمعتْ اللماذا بالكيف، اجتمع العلم بالأدب…
وقد أكد الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور الفكرة بالقول ، إن على الفيلسوف أن لا يكتفي بالبحث عن حقائق العالم الخارجي ، بل يتساءل أيضاً عن حقيقة الذات …
فإذا كانت الفلسفة تتكيء على الحجج والبراهين ، والشعر على إثارة المشاعر والإنفعالات ، فإن الوسيلة الوحيدة لجمعهما هي اللغة في سياق تطوّر مفرداتها ، فالشعر يغذّي الذائقة الجمالية باللغة التي لا يجب أن تكون وظيفة أداتية مجردة فحسب ، وإنما تنضاف إلى أغراض فنية وجمالية تكسر الهوة بين الشعر والفلسفة كون الشعر يعكس العاطفة والمشاعر التي تمور في الأعماق، أما الفلسفة فهي تأمل عقلي ونظرة شمولية للحياة والكون…
يقول ت.اس.إليوت أن الشعر يوهمك بأنه يتضمن نظرة إلى الحياة كما هوميروس وفيرجيل وشكسبير ودانتي، فتجنح إلى الإعتقاد بأننا نتابع شيئاً يمكن التعبير عنه فكرياً ، ما يعني انفصاله عن الفلسفة والفكر… من هنا عكس هايدغر نظرة ت.أس.إليوت طبيعة العلاقة بين الإثنين ، حيث اعتبر أن كل تفكير فلسفي تأملي يكون شعراً كما يمكن للنص الشعري أن يحمل بذور التفكير الفلسفي…
…ويبقى السؤال
هل تتم المصالحة بين الفلسفة والشعر؟..وكيف سمحنا للرواية والقصة القصيرة أن تكونا مسرحاً للشعر ، ولم نفعل ذلك مع الفلسفة والحكمة؟ هل لأن أفلاطون في كتابه الجمهورية استهزأ بالشعراء وطردهم من جمهوريته باعتبارهم مقلّدين غير مبدعين وكاذبين ومفتنين ولا يمكن أن يرقوا إلى مستوى الفلاسفة !؟
تصالح آنشتاين أول عالِم معاصر في العالم مع الشاعر الفيلسوف طاغور أحد أكبر الشعراء في الهند …
هل ستتم مصالحة العلم والشعر كما فعل العلم مع الفلسفة ؟!
أسئلة قد نجد أجوبتها في مكامن الزمن…
بين العلم والدين
يشير كتاب فيزياء الإيمان للكاتبين الروسيين ف.ي تيبخيولاف وت.س تيبخولاف دار علاء الدين – ترجمة د.شريف الحواط -طبعة أولى 2014 إلى دعوة تصالحية بين العلم والدين، وذلك عبر مفهومين أساسيين: الدين بلا برهان، والعلم بلا إيمان. وضمن هذين التحديدين تندرج معطيات أساسية وكثيرة لتميط اللثام عن الصراع القائم بين الدين الذي قرر السيطرة على الإله، فاعتبر نفسه الوكيل الحصري والظاهر على تنظيم شؤون الخلق بمرسوم إلهي، وكأنه يعتبر أن الإرادة هي شأن غيبي لا يعلمها إلا مبدع الكون – الله. ثم جاء العلم ليتقاسم مع الدين سلطة البحث عن الإله، وذلك بطريقه البحثية التي اعتمد فيها التجريب دون افتراض وجود الله… لكنه توقف في البحث عن الحقيقة بعد أن أدرجت محاولاته ضمن سياق مادي بحت بعد أن أخرج كل دروس الفيزياء والكيمياء والرياضيات ليجعلها علماً يقوم على مبدأ البحث عن الطبيعة الكونية ومفهوم الإله، مبيحاً لنفسه تدمير الكوكب عبر مقولة ” الغاية تبرّر الوسيلة، نافياً أي دور للأخلاق في العلم والتي اعتبرها العلم نظرية دينية مما أثار سخط الصفوة الدينية التي لا ترغب في اقتسام السلطة والمجد مع أي كان، وقد جاءت القرون الوسطى المظلمة لتضرم النار عبر محاكم التفتيش، وتبدأ العلاقات بين العلم والدين تأخذ طابعاً عدائياً…
يجيء الباحثان تخيبولاف في كتاب فيزياء الإيمان ليشرحا فكرة انه لا بدّ من الإعتراف بعدم التناقض بين الفرضية العلمية والتفكير بالعالم الباطن والله عبر آلتين ، الحدث الذي هو اتصال الوعي بالوعي الباطن ( اللاوعي )والعقل الذي هو آداة لسوء التفاهم بين البشر والكذب، عبر محاولة ربط العلم بالحدس …فجاء الغرب (العلم) ليقدم معارف دقيقة ومحدودة ، بينما( الشرق) اكتفى بالإيمان لفهم العالم والإنسان. هذا ما حدده العالم الألماني ألبرت آنيشتاين بأن العلم بدون دين ناقص ، أما الدين بدون علم أعمى…
هو ما أكده ايضاً العالم الفرنسي شيوريه في نهاية القرن التاسع عشر حين أعتبر أن الدين يجيب على
أسئلة القلب ومن هنا تنبع قوته السحرية ، أما العلم فيجيب على استفسارات العقل ، ومن هنا تنبع قوته التي لا تُقهر…فالدين بلا برهان والعلم بلا إيمان يتواجهان بغير ثقة فيما بينهما وبصورة عدائية وهما غير قادرين على أن يتغلّب أحدهما على الآخر…
لذا اعتبر أكثر الحكماء والمفكرين بعيدي النظر في الشرق والغرب ، أنه لا بدّ من ربط المعارف العلمية بالمعارف الأدبية، والمساواة في “الحقيقة” بين ما هو حاصل بنتيجة الاستمارة، الوحي أو الإلهام ، وبين ما هو معتدل عليه بالتجربة الدقيقة والبناء المنطقي …
 غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
ويذهب الباحثان إلى علاقة العلم والعالم الباطن عبر الفيزيائي الروسي غ.ي. شيبوف، حول حقل الدوران الذاتي ( السنين أو حقل الفتل ) وتثبيت مفهوم الخلاء الفيزيائي وحقول الفتل، توصلت الفيزياء إلى “ضرورة قبول العقل الأعلى المطلق-الله ، الذي يلعب الوعي الإبتدائي فيه الدور الحاسم على مستوى الواقعية الأولى، ويقوم بدور البداية الفعّآلة دون أن يخضع الله للوصف التحليلي ” ، وإن الإعتراف بالطبيعة الفتلية للوعي نلغي السؤال الأول المعروف في الفلسفة أيهما ظهر اولاً…الوعي ام المادة؟ وهو ما عرضه الفيزيائي دافيد بوم في العام 1989 حين قال إن الزعيم الروحي لاما قال :”نحن البوذيون نعتبر أن في الطبيعة قوتان أساسيتان: المادة والوعي ، وبلا شك يتعلق الوعي إلى حد كبير بالمادة ، وأن تغيّر المادة يتعلق بالوعي ، لذا فأنا أعتقد أن البحوث في مجال الفيزياء وعلم الأعصاب يمكنها أن تعودنا إلى اكتشافات جديدة لا مثيل لها ” (ص 35).هذا الكتاب “فيزياء الإيمان” يورد افكار موضوعية ومنطقية في فهم صيرورة الكون الأقرب إلى المعادلة الوظيفية في خدمة الوجود والكائنات الحيّة فيه بدءاً باحتراف العلم بالخالق مروراً بالجوانب العلمية لأسرار الكون (تقلبات الأثير وتجربة فيزو ومايكلسون وآينشتاين والميكانيك الكوانتي ونظرة بل والجسيمات المضادة والإفتراضية ، واستقطاب الخلاء وصفاته ومستويات حقيقة البناء الكوني عبر ثلاثة حركات العدم المطلق وحقل الوعي في الكون والخلاء الفيزيائي إلى حقول الفتل )وإذا كانت التجربة العلمية عند الفيزيائي الفرنسي أ.ي.فيزو التي تقول أن ” المادة المتحركة على الأرض لا تجذب إليها الأثير المحيط بالأرض وإنما الأثير المحيط بالأرض هو وحده الساكن بالنسبة للأرض دون اقتراح فرضية حول سكون الأثير الكوني بكامله…
تعتبر تجربة مايكلسون التجربة السلبية الأعظم في تاريخ العالم حول سرعة الضوء بالنسبة للأثير الساكن بعديم وزنه كجوهر حقيقي ، وأنه بقدر ما تتحرك الأرض في الفراغ ، وعلى هذا يدل دورانها حول الشمس ، بقدر ما تتحرك في الأثير ، قياس سرعة شعاع الضوء المتحرك باتجاه متطابق مع أنحاء حركة الأرض مع اتجاه الجريان في الأثير ، وكذلك سرعة شعاع الضوء المعاكس( عكس اتجاه الجريان في الأثير ) فمن السهل التأكد من الفرق بين السرعتين. هنا ينشأ استنتاج واحد هو أنه لا حركة للأرض عبر الأثير ، وبالتالي فإن فرضية الأثير الكوني الساكن التي علقت فيها الفيزياء الكلاسيكية آمالاً كبيرة غير صحيحة…
إذاً ، جملتين إحداثيتين مرتبطة بالأرض في تجربة مايكلسون وفي جملة ساكنة في تجربة فيزو ما هو
إلا شيء خطل لا معنى له…
وكذلك الأمر حول مبدأ عدم التعيين عند نيلسن بور وتفسيره للنظرية الكوانتية ” إن الفيزياء تصف الكون، والآن نعرف أن الفيزياء تصف ما تستطيع قوله عن الكون ، حيث تفترض هذه المدرسة أن وجود الكون الذي يبتدعه الفكر البشري بشكل سحري جعل آينشتاين يقول عن هذه النظرية ” إذا كان الراصد المرصود كلياً أو جزئياً، فإن بامكان الفأر أن يعيد ببساطة تشكيل الكون لمجرد النظر إليه ، هذا الأمر يبدو سخيفاً ، وأن هذه الفيزياء الكوانتية تحتوي على خلل ما مجهول وكبير “
وهناك آراء أخرى وقعت في أساس الطبيعة ضرب من ضروب الحتمية(اليقين) الذي ما زال يفلت من حقل الرؤية للباحثين هذا الرأي تمسك به ( بلانك،آينشتاين،دي برويل،شرودنغر، ولورنتس ) ص 72.
أما جون س بل فأكدت نظريته على الصلة التي تربط معادلات الميكانيك الكوانتي وتماثلها بنيوياً مع الكون فإن إتصالاً ما موجود غير موضعي بين جسيمتين دخلتا في وقت مضى في تماس بينهما .
إن جميع النماذج ما قبل الكوانتية للكون بما فيها نظرية آينشتاين النسبية(انحناء الفراغ) افترضت أن أي ارتباطات وجودية تتطلب علاقات متبادلة بدءاً من فيزياء نيوتن(ميكانيكياً ويقينياً) الترموديناميك والكهرطيسية(تقاطع أو تفاعل الحقول) والنسبية (المكان) . مثال طاولة البلياردو صدمة من كرة أخرى ، إمالة الطاولة ، اتجاه الكرة عكس عقرب الساعة .
الوعي والروح
بعد جهد الفيزيائيين في تحديد وشرح القوة الخامسة للكون، يذهب الدالاي لاما إلى “اعتبار كل شيء في نهاية المطاف يتكوّن بالوعي، وأن مستويات الوعي متعددة ، وأرفعها أبدي “.
هنا يبدأ البحث عن القوة الكامنة والباطنة وهو ما ادخل علم النفس البشري مدار اللعبة الكونية ، وذهب التنويم المغناطيسي ليشرح اللاوعي بمنظور علمي فاستبدل الدكتور بادروس في كتابه التنويم
المغناطيسي مفهوم الوعي – الجسد بمفهوم
” الواحدة النفسية الجسدية” كما آينشتاين في مفهوم المكان-الزمان في فصل واحد ) الزمكان)
الحقل الفتلي
توصل العلم الحديث إلى أن الحقل الفتلي الكلي للإنسان يمتلك دوراناً نحو اليمين ، ويمكن أن يوجد لدى شخص واحد من بين عدة ملايين حقل فتلي ذو دوران نحو اليسار ، ويمكن أن يؤثر على حقله الذاتي . مما يعني أن السر يكمن في الإنصباب نحو حركة الواجد لا الموجود ، ومنه تبدأ الرؤية العلمية…
يذهب الكتاب ( فيزياء الإيمان) إلى وقائع حسية واستنتاجات نُفّذت في معهد الطب التجريبي والسريري لأكاديمية العلوم الروسية ،فيعتبر أن “المادة الحيّة (الروح) تُصمّم في البدء نفسها على شكل نمط هولوغرافي (مجسّم) وعلى أساس هذا النمط تحديداً تبني المادة لها جسماً بيوكيميائياً أرضياً محدداً…يعني أن ثمة جانبان للحياة وأن الأول منهما هو الجانب الهولوغرافي الحقلي”
ويذهب ب.ب.غاريايف في المعهد إلى ” أن كل مخلوق حي ينشأ وفقاً لبرنامج موجي معطى مسبقاً،
الحمل الظاهر في الكتاب المقدس) ولّدت مريم عندما نقل الروح القدس إلى صبغياتها الهولوغراما الموجيّة للذات الإلهية”.
لقد بحث العالمين ب. غاربايف ومساعده غ.تيريشيني ، حول فكرة الوصول الى البروتينات وال DNAوRNA والتي تتجمّع في جسم معقّد ، اتجها إلى قضية مريم العذراء (الحبل بلا دنس) فقررا الإحتكام إلى التجربة واختبار إمكانية الحمل البريء ،فماذا لو سلّط شعاع الليزر على السائل المنوي الذكري ومن ثم وجّه الشعاع المنبعث من السائل إلى فتاة شابة؟
لم يتم استدعاء الفتاة ، وأخذ السائل المنوي داخل الموجة الساكنة يعطي ومضات برق خيالية بكل الألوان الممكنة ،وقرر العالمان أنهما أوجدا الضوء الصانع للحياة .ص 138.
ماذا لو لم تكن ضوءاً وظنناها كذلك، ربما هو “النور” الذي يخلق نفسه من كل شيء ، لأنه هو نفسه خالق لكل شيء.
المعرفة الإيحائية هي الضوء الصانع للحياة، وليس البشر إنساناً لأنه لم يكتمل بعد. لماذا صورة “على خلقه ومثاله” إذاً؟!
هنا لا تتجسّد المعرفة الوحيانية المادة فيها مادياً وإنما نُقلت عن بُعد من العالم الباطن…إنها قدس الأقداس، وإذا ما قرر العلم أن يتابع أبحاثه بجدية لأنه لا يجب أن يقف، كي لا تبدأ الحضارة بالمراوحة في المكان ، لكن يجب أن يبقى بعيداً عن سر الروح -الله ؟!
فإذا كانت الفيزياء قد حققت برهانها بالكوانتات التي تولّد الإهتزازات وتختفي ، ويهتز الحقل الكهرطيسي، تولد الفوتونات وتنفذ، ويهتز الحقل البيوني، وتظهر ميزونات بي وتختفي وهكذا…فهذا يعني أن قوة خارج الفيزياء تدفع الحقل الفتلي لكي يرسم لنا هذا الكون هو الروح.
وكما يقول غ.ي.شيبوف :”حلول دقيقة حول الخلاء الفيزيائي أتاحت إبراز سبعة مستويات للحقيقة في البناء الكوني ووصفتها رياضياً”. ويعتبر الخلاء الفيزيائي هو الناقل للتفاعلات الفتلية…
هنا يبدو السؤال بارزاً وواضحاً : هل استسلم العلم لرأي الله ، أو أنه يرغب بالمصالحة معه.؟ فيما تبقى المحاولات جميعها فيزيائياً وميتافيزيقياً تبحث عن جوهر واحد ،من العلم والفلسفة والشعر لندخل ملكوت المعبد الأخير ؟
إذاً علم الروح لا يعرفه إلا المبدع الأول – الله ،
ما يقوله البروفسور إي. ب. فولكوف بصدد الروح الآتي: إن “جسد الإنسان هو ظاهرة العالم الكثيف وتجسّد الحالة النفسية للإنسان ( الروح ، التمثّل بالجسد) في ذاتها قوانين العالم الباطني، ولكن يوجد ما يوحّدها أو يفرّقها كالمبدأ الفضائي المتسامي- الروح” وسيّان الروح ما تفعل- أن تفرّق أو توحّد ، فهي تعمل بلا أخطاء .
ويعتقد فولكوف أيضاً
أن الروح تفارق الجثة بعد موت الإنسان بيولوجياً، وتغيّر من صفاتها، وتواصلُ بقاءها بأشكال أخرى في العالم الباطن تبعاً للقوانين التي تحكم أداءها الوظيفي بانتظار تجسيد أرضي آخر لها ، وأنها تغادر الجسم لا بشكل سلس وإنما على دفعات…ص 148 .
وحول تجربة مغادرة الروح الجسد قرر الطبيب الفرنسي إيبوليت باراديوك القيام بمحاولة رؤية الروح المغادرة مستعملاً جهاز ضوئي خاص ، ليلتقط التغيرات الخارجية الحاصلة وتسنّى له ذلك حين وافت زوجته المنية ، فأظهرت الصورة إنه بعد 15 دقيقة من الوفاة ثم بعد ساعة ثم بعد 9 ساعات، رأى ضباباً نصف شفاف ثم سحابة غطّت كامل الصورة حتى أصبحت السحابة قطعاً من الضباب المتبعثر . وقد تم تسجيل جسم طاقي نصف شفاف إهليلجي الشكل ينفصل عن الإنسان لحظة وفاته، بعد ذلك يتوارى الجسم في الفراغ ( الفضاء).ص 170 .
يبقى هناك سؤال وجودي عصي على كل العلماء والفلاسفة والشعراء : ما الجدوى من وجودنا في هذا الكون العظيم وبماذا نؤثر نحن في فيزياء الخلاء ؟ هل أوجدنا المبدع الأول ليكتشف نفسه؟ هل يريد الخالق أن يوجد معجبين له ليكتشف جماله؟ فلنترك العلم يبحث والفلسفة تتمنطق والشعر يصوّر لنفهم سر الوجود.
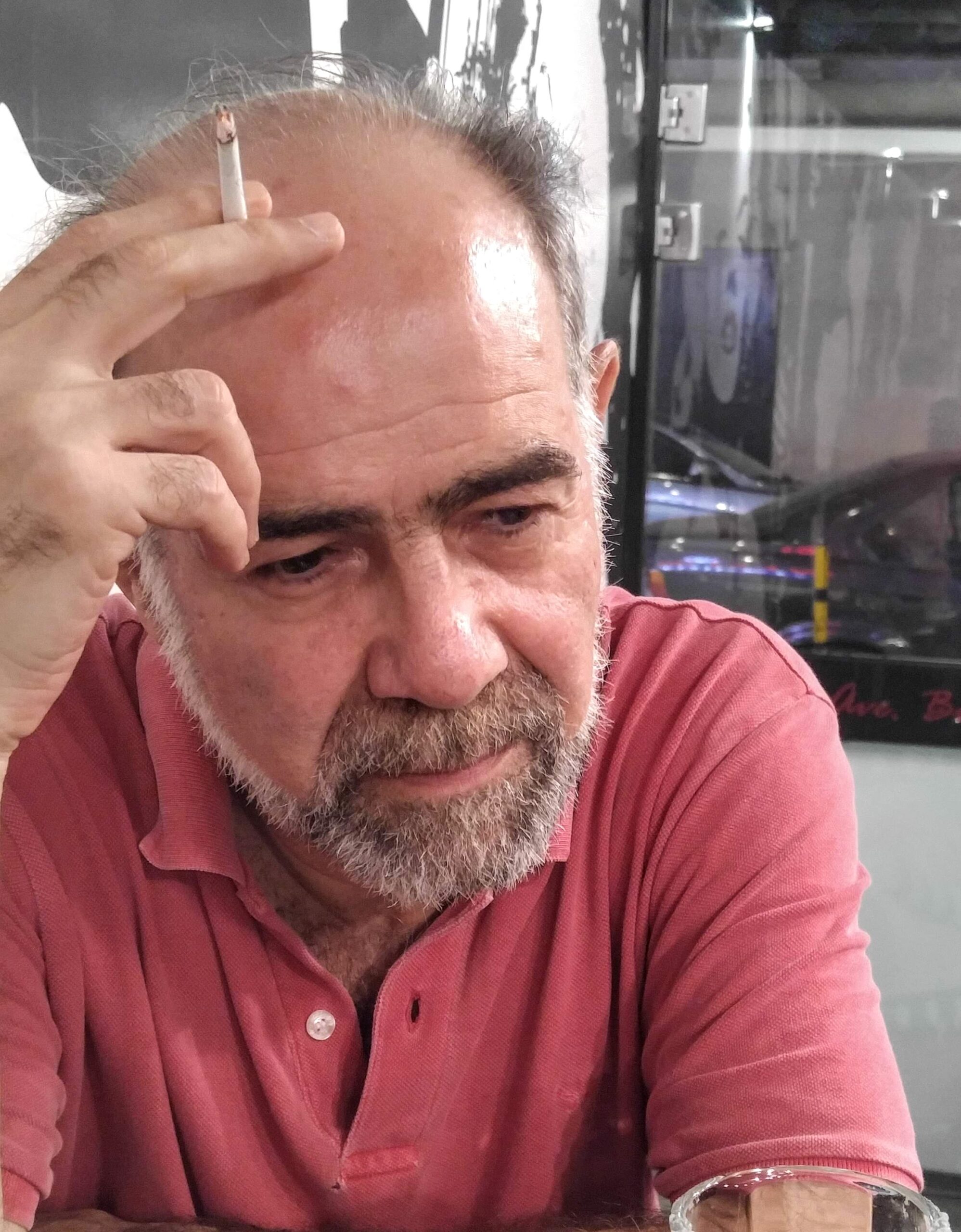 نعيم تلحوق
نعيم تلحوق








