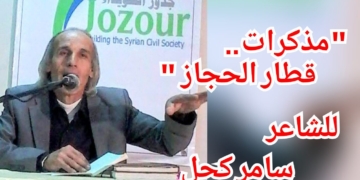ليس عبثاً لُخّص العمر برحلةٍ في قطار..
بقلم الكاتبة مُزنة فؤاد بلّان
-×-×-×-×-
ترافقني رهبةٌ غير مفهومة وحصرية كلّما اضطرت قدماي لارتياد محطة القطارات الكبيرة أو الbahnhof في تسميتها الألمانية والتي غالباً ما أحاول تجنبها ببدائل أخرى كالu-bahn (Untergrundbahn مترو الأنفاق) أو الباصات. رهبةٌ لم أعهد مثلها في المطارات المهيبة الحجم والضخامة ولا حتى عند قيادتي للسيارة لأول مرة في حياتي منذ سنواتٍ بعيدة واقتحامي لجموع السيارات المسرعة من حولي بتشبّثٍ قلق بمقودٍ لا أثق إلى أين سينهي بي المطاف.
مشاعرٌ متخبطة كتلك التي رافقت ثورة القطارات في القرن التاسع عشر، وتجلّت في العديد من الأقوال لأشهر أدباء ذاك العصر. منهم من مجّدَ هذا الاختراع ومنهم من لم يتقبله كغوته شاعر ألمانيا الشهير الذي قال: القطار مثال للرداءة.
في حين كان مادة دسمة للعديد منهم كالأديب التشيكيّ المولد الألمانيّ اللغة(فرانس كافكا) الذي كان قد ذكر مراراً أن الكثير من قصصه ورواياته قد وُلدت أفكارها إما داخل القطار وإما بإيحاء منه، كما في مجموعته “سور الصين” والتي فكّر في كتابتها حين شاهده وهو يستقلّ القطار مما أوحى له بفكرة هذه المجموعة القصصية.
كما قصص حبٍّ نشأت وترسخت في القطار كالتي نقلها لنا الفنان الإسباني(سلفادور دالي) في الكثير من أعماله ولوحاته التشكيلية التي أثرى بها عالم الفن. حيث كان يلتقي فيه بمعشوقته ويجوب بها أرجاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقصص الجنود والمحاربين وهواجسهم في «وصل القطار في موعده» للأديب الألماني (هاينريش بول)، وكانت من أبرز قصص مجموعة ١٩٤٧ التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية وضمت العديد من أهم الأدباء الألمان فيما عُرِف بأدب ما بعد الحرب. بطل هذه الرواية القصيرة جنديّ ألماني مأذون يركب القطار في عام ١٩٤٣م ليلتحق بالجبهة الروسية. فجأة تستبدّ به فكرة أنه لن يصل أبدًا، وأن تلك الرحلة هي رحلته الأخيرة، وأن القطار سينقله إلى قرية حيث ينتظره الموت. وفي القطار يواصل حياته العادية، يأكل وينام، ويلعب الورق مع أصدقائه الجنود. وهو يتذكر فصولًا من حياته، ووجوهًا من الماضي، ويحاول أيضًا أن يصلّي. ويتقدم القطار في رحلته عبر ألمانيا ثم بولندا. وحين لقائه بفتاة بولندية يتوهم أنه سيفلت من المصير الذي ينتظره، فيهرب معها في سيارة يسحقها القطار بدوره، فتكون النهاية كما توقعها!
فيما علماء تولدت لديهم شرارة اختراع ما (كإنشتاين) والذي صرح قائلاً : في القطار ساهمتُ في أبشع اختراع “القنبلة الذرية”!
أما ما لفتني قول الشاعر الفرنسي (غيوم أبولينير): أخشى اليوم الذي لا يحرّك القطار فيه مشاعرك.
لأقول له بدوري: اطمئن فلم يأتِ هذا اليوم بعد!
رحلتي ذات يوم..
نهارٌ صيفيٌّ بامتياز أرّق الحرّ جفوني يومها. لأنام عدد ساعاتٍ أقل مما يتطلبه استيقاظٌ مبكّرٌ في صباح اليوم التالي.
رحلةٌ يتوجبّ انطلاقها عند السابعة صباحاً، يسبقها قدومي بحوالي نصف ساعة كبداية أولى لمراحل الحرص الذي يلازمني في هكذا رحلات.
متسّعٌ من الوقت يسمح لي دوماً بتأمل وجوه الركاب والمسافرين الكثيرة، في تعجّبٍ لقدرة الخالق على تفرّد ملامح كلٍّ منها.
ثم أتابع التحديق بشرود، ليخالني أحدهم معجبة بلحيته الكثّة أو بعضلاته المفتولة..
فأتنبه حينها لضرورة إزاحة نظري!
يأتي القطار مسرعاً إلا أنه ليس القطار خاصتي، فما زال هناك بضع دقائق على وصوله. أتابع فيها تأمل الركاب خلال عملية الصعود. لهدوء بعضهم الواثق بالتحاقه، وتلاهث المتأخر منهم بسرعة جريٍ قد تنافس سرعة الإغلاق الأوتوماتيكية.
تنغلق الأبواب لينطلق بعدها القطار الأحمر الطويل بعرباته المحمّلة بالوجوه بمرورٍ مخيف، أحمد ربي حينه أن وزني يتجاوز ال ٥٥ كيلو مما يبعد احتمالية طيراني مع إحدى هبّاته.
عشر دقائق وصل بعدها قطاري العزيز والذي لا أبالغ إن قلت إنني أدقق في رقمه ووجهته مرّاتٍ
عديدة، أقرؤها بنظارة شمسية وبدونها فلعلّ بقعة عالقة على إحدى عدساتها قد تجعل من الرقم واحد اثنين! أتوكل على الله بعد عملية التمحيص هذه وأدخل ، امم أين سأجلس؟! أحدّق في الوجوه مجدداً وأختار من ينشرح له صدري لأجلس بجواره، اللهم فيما ما عدا إذا كانت الكراسي المجاورة للنوافذ ممتلئة حيث لها الأفضلية دوماً وأبداً.
أفكر في عظمة شبكة الطرق هنا في ألمانيا وكم التنظيم والدقة الذي يرافقها.
أفكر كم من راكبٍ يرتاد هذا القطار يومياً دون أن يترك أثر. وكيف أن مرورنا كله يلخص في حقيبة!
وإذا حدث ونسي أحدنا هذه الحقيبة أو ما شابهها من أهمية ماذا سيحصل؟
إحساسٌ يجعلني أتشبثّ بحقيبتي وأكياسي كأنها ولدٌ من أولادي.
تبدأ الرحلة وتبدأ معها حواسي بالتأهب، عينٌ على الجوال وعينٌ على شاشة خارطة الطريق أمامي. فيما تنتظر أذناي سماع ما تمليه علينا تعليمات الميكروفونات الناطقة لأسماء المحطات القادمة وما شابه.
يتخلل هذا التركيز الشديد شرودٌ لا أستطيع تجاهله حتى في أعقد اللحظات، والذي يرافقني تحديداً بمحاذاة النوافذ، التي عادةً مع كل وقفة عندها ومهما كانت إطلالتها أُفرغ عبرها شيئاً ما من داخلي. حتى تلك المستهترة العابرة منها بعد زوال الدهشة واستطلاع البدايات التي يدفعنا الفضول نحوها بسرور للوقوف عليها أيّاً كان موقعها حتى لو على أنابيب الصرف الصحي في البناء المجاور، حتماً ستوحي لك بشيءٍ ما. تلقائياً تأخذ نفساً عميقاً تسترجع ذاكرتك جزءاً من نشاطها، تعبث بمخيلتك، تسافر معها برحلة قصيرة حتى لو كانت خاطفة كرحلات بساط الريح بمعناه الكرتوني وليس المخابراتي!! تغرق إما في حزنٍ شديد أو في فرحٍ شديد، تبعاً للعبة الصدفة في البؤر الحسية للمخ ،أو حسب ما يتراءى لك خلال هذا الشرود، فكلٌّ له دلالة ما تثير انتباه تلافيف ذاكرتنا أو أفق مخيلتنا المثقلة بالأهداف وهمومها. فتبتسم معها تارةً كالمجانين وتارةً أخرى تتجهّم كأحد ضبّاط القوات المسلحة.
الوصول الأخير
أصل بعدها وجهتي بزمنٍ شعرت بتجاوزه الوقت الأصلي. رنينٌ متتابع يرافق عملية انفتاح الأبواب، أقف قليلاً منتظرة دوري بالنزول ريثما تترجّل أمٌّ بابنها الجالس في عربته. لحظاتٌ يخال لي حينها أن دولاب العربة سوف يخوض معركة شاقة بين حافة القطار والسكة ،قد يسقط الطفل في نهايتها أو يبقى عالقاً، توترٌ تكاد لا تشعر به أمه ذاتها.
أتنفسّ الصعداء لنزوله سالماً، ونزولي أيضاً! وأمضي إلى وجهتي بنشوة المنتصر.
مُزنة بلّان
 الكاتبة مزنة فؤاد بلّان
الكاتبة مزنة فؤاد بلّان