عويل الأمكنة
في الناحية الثقافية، سيكلف وليد عبد الصمد نفسه، بتصميم الأمكنة في داخل نفسه، مشاركة منه في إعادة الوقوف عليها، على غرار جميع الأدباء والشعراء، الذين علقت نفوسهم بالأمكنة، منذ كانت لهم جادات لهو وفراغ وعذوبة.
هذا الأمر الذي يتكرر في نفس الأديب الواعد: (همس الأماكن، فواصل. الفرات للنشر والتوزيع. رأس بيروت. شارع عبلة. بناية البخاري. ط 1: 210 ص)، يعزز الإعتقاد السائد، إن الأماكن إنما تشجع على الوله بها. إنها تغري بنفسها، مثل النساء. إنها تشجع، على الوقوف عليها. والبكاء في عرصاتها، مثلما فعل شعراء الجاهلية. ومثلما فعل شعراء النهضة الفرنسية. ومثلما يفعل جميع الشعراء الذين يبلغون “سن الشعر”، فلا يجدون إلا الأماكن، يفيضون فيها. فيصح بالتالي فيها، “أول التنزيل”.
عبقرية الأماكن، أنها جاذبة لغيرة الأدباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين. حيث هي ملاذ توحدهم. حيث هي ملاذ توحيدهم. حيث هي ملاذ وحدتهم.
الأماكن وحدها، قادرة على همس هؤلاء جميعا، لمعاشرتهم معا، في برهة التجليات. الأماكن وحدها موطئ قدم النابهين والنابغين. حيث يتحول المهجور منها، إلى مأنوس. نستمع للأديب وليد عبدالصمد، يقول في (الإهداء ص5):
“إلى كل من صاغ كلمة لتسمو في الوجود/ إلى كل ذواقة يعشق عطر الحروف/ إلى كل ملهمة أرشدتني لنثر همس البوح/ إلى كل معذب ومقهور في عالمنا المكتوم/ إلى كل دمعة ألم تنهمر بسكون/ إلى والدتي/ إلى روح والدي/ إلى وطني/ إلى بيروت.”
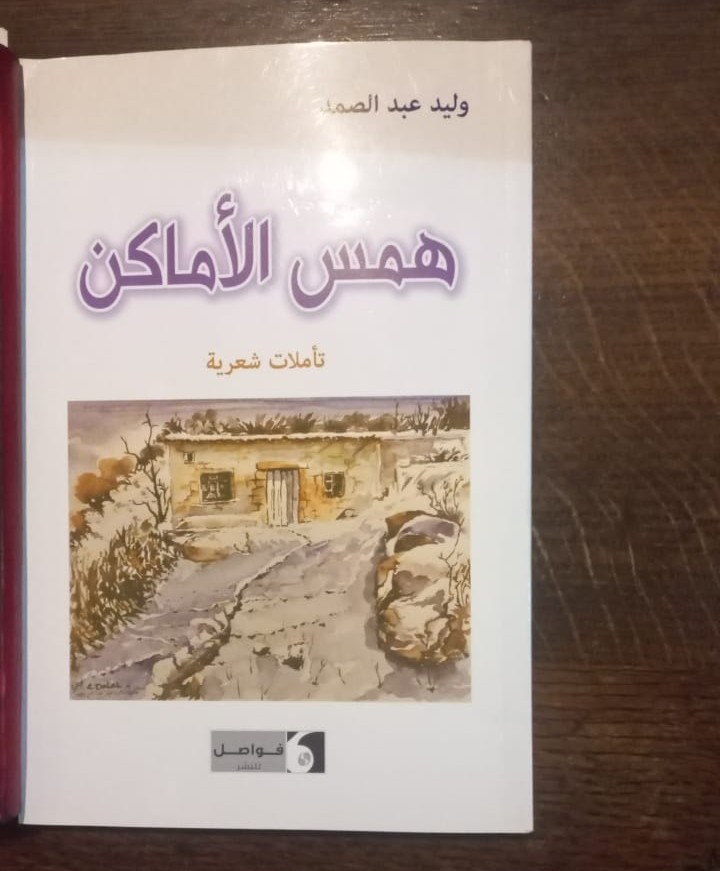
يحاول وليد عبد الصمد، أن يرفع وعيه برافعة من الطابع الثقافي الغني بالمكان: الوطن، وبيروت. إنه متحف ذاكرته الواعية، لجمليات الأمكنة. لشجى الأمكنة، لعويلها، في ذاته المتقدمة في الزمن الأدبي الذي بلغه، أوان بلغ سن الأدب والشعر. فاض في المكان: بيروت ولبنان. فإذا متحفه يكتمل، هندسة ومعمارية ونشيدا وطنيا. ومجموعات فنية فريدة، أين منها، تلك العناوين التي بلغت شأوى الخمسين عنوانا أو يزيد. وهي فيض عمره كله الذي عاشه، حتى أوان كتابته نصوصا بمداد العيون. نستمع إليه يقول في مقطوعته (منذ الأزل-ص38):
” شقي عباب البحر بأشرعة يديك/ خذيني إلى قصرك المزروع على ضفاف أنهاري/ ولتعزف البلابل والحساسين ألحان الحب/ ولنرو عطش السنين عشقا ولهفة/ بين عطور الرياحين/ بين نجوم المساء/ بين أصداف البحار/ بين قلبينا.
همس الأماكن، عادة غجرية. عادة بدوية. عادة الريح والأرياح والأرواح. عادة الطيور والوحوش التي باكرت في الخروج. همس الأمكنة، هو أيضا منصة همس فعلية. حدث أداء، من نوع آخر. من محتوى نفسي، يعزز وعي الشباب في برهة الوعي بالمكان وبالشعر على حد سواء. يجعل من هذة الأضابير المرصوفة والموصوفة، متحفا للفن الإقليمي، والمساحات المفتوحة على المحيط. فمن منا لا يذكر مطلع المعلقة لإمرئ القيس. اول شاعر عربي وقف وإستوقف وبكى وإستبكى، حيث يقول:( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل/ بسقط اللوى بين الدخول فحومل/ فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها، لما نسجته من جنوب وشمأل.) نستمع للأديب والشاعر الواعد، وليد عبد الصمد في مقطوعته (العشق- ص118) يقول:
“تهيم ملامحنا على شفق عمر تغبر/ وخضرة الأرض تنبت في مكان تصحر/ هكذا العشق يأتي من زمان تغير/ فلا تسأل ولا تجب على سؤال تحير.”
أتحدث عن وليد عبد الصمد، الجندي المجهول في الجيش اللبناني اليوم. شاعر غادر صفوفه. فإصطفت الدموع على خديه من العويل على فراق الصفوف. من العويل على الأرض التي سكنته، أكثر مما كان يسكنها. بذلك إذن، عرف كيف تنتقل الأماكن معه، تعبئ جرارها من بدنه الذي ينضح عرقا وطيبا وترابا، فيه رائحة الذي واراهم في ثراها من الأهل والأحباب. يقول في قصيدة (جيش لبنان- ص119):
“جيش لبنان دوما سيبقى الخلاص/ ما همهم أعداد وأثمان الخسائر/ فهم للوطن كما العهد ذخائر/ جنود يحاربون ببسالة الإرهاب./ وقلوبهم كالصخر لا تهاب./ من كل لبنان يلبون للواجب النداء.”
التحدي المطروح على الشاعر، أن يسجل العفوية بكل أمانة، لا أن يساجل “صناع الشعر”. ولهذا ربما، يركز بشكل أساسي، على “النقل الحرفي” للأوجاع. للهمسات. للشجى. مستلهما ذلك كله من “عبقرية الأمكنة” التي رعته، حين كان يترعرع فيها. والتي يخشى أن ترعاه كما أجداده، على حين غرة، ويكتمل الردى فيها، قبل أن يستكمل تدويناته الشجية حبا ووفاء لها. يقول في قصيدة ( إبتعدوا- ص 150):
إبتعدوا/ فإني لسعة شمس حارقة/ لدغة أفعى… عقصة عقرب/ إبتعدوا/ فإني موبوء بكم/ أنا الملح على الجرح/ بل أكثر… ربما أسيد يتبختر/ زئبق يهرب من إبرة/ يزرع خنجرا في مضجع/ إبتعدوا/ السم في حرفي/ وكلماتي هي المقطع…”
ثم تراه ينتهي للقول:
” أنا رمح/ يجرح خدا بالدمع/ يقطع وريدا من شوق/ بخبث رجل لا يقنع/ ولا ترنو إليه/ كل الكتب والأقلام/ كل العشاق/ كل الأنبياء والحكماء/ إبتعدوا… إبتعدوا…/ إبتعدوا..”
يشرح وليد عبد الصمد فكرة الأماكن. يشرح همسها. يشرح مأنوسها ومجهولها. في هاجسه في حله وترحاله. لأن عويلها لا يزال يملأ عليه كيانه. فلهمس الأمكنة عويل وأيما عويل. و”من يذق ير”، كما يقول رجال الصوفة، في برهة التوحد مع الذات. نستمع إليه، يقول من الخواتيم، قصيدته (عابر سبيل- ص185):
أسير وحيدا إلا من قلقي/ أعاهده بثوب خشوع/ أن لا أبعده عني/ وأن أبقى حرا/ حروفي تساورني/ فيض ألم وشكور/ القادم مسرعا … متطفلا/ ليروي سقم حرية مقيدة/ بالخوف والرهبة/ يسطع ليلي برشفة أمل/ تتكور معها الأحلام/ كسبيل يمر بجانبنا،/ كطفل يعاتب لعبته القديمة/ كفتاة تبيع الورد لسائق/ مل زحمة السير.”
ثم تراه يقول في قصيدته (زعماء- ص193):
وطن الزعماء هذا أنا/ حدق لعلك تعرف من أنا/ أنا قيمة إنسانية/ أنا حضارة لبنانية.”
يغفر لوليد عبد الصمد، الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي، حين وطأ أرض شعره، قلقا. لأن إيليا كان قد إصطاده القلق الوطني، قبله بقرن من الزمان. وحين يعود الأديب وليد عبد الصمد إلى أرض القلق لبنان، لابد أن يستنير بالشعل التي سبقته على دروب الهجرة من المكان، للعيش في رحابة الزمان.
د. قصي الحسين
أستاذ في الجامعة اللبنانية.









